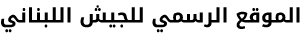- En
- Fr
- عربي
كلمة المهندس أحمد نظام
حضرة العميد الركن فادي أبي فرّاج مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية،
حضرة الضباط،
أصحاب السعادة،
الزملاء والحضور الكرام،
أريد أن أستعرض سريعاً مجموعة من النقاط حول نطاق عمل مؤسّسة المياه في جنوب لبنان، قطاع المياه، قطاع المياه في نطاق المؤسّسة، السدود والنواقل المُقترحة في الجنوب، ومقارنة حول إدارة المنشآت الحالية مستقبلاً وتشغيلها وصيانتها.
يتضمن نطاق عمل المؤسّسة محافظتيّ الجنوب والنبطية، ونحن نخدم حوالى 750 ألف مواطن لبناني، مع العلم بوجود مشكلة في هذه الأرقام. كان يوجد سابقاً في جنوب لبنان أربع مصالح: مصلحة مياه صور، مصلحة مياه صيدا، مصلحة مياه جبل عامل، ومصلحة مياه نبع الطاسة، واستُحدِث في أوائل العام 1990 مشروع وادي جيلو. وسأعود بالذاكرة إلى العام 1990، عندما كنت مدير مصلحة مياه «عين الدلبة»، بجانب مستشفى قلب يسوع، لأستعرض موضوع إدارة قطاعات المياه في لبنان. لقد كان نبع «عين الدلبة» الواقع تحت ثكنة حمانا امتيازاً في الأربعينيات، وكان يروي بالجاذبية كلّ منطقة الحازمية وبعبدا والفياضية والجمهور واليرزة وحارة السّت وصولاً إلى برج البراجنة. وكان هناك مشروع مماثل هو «نبع الطاسة» في بلدة اللويزة في جنوب لبنان، وكان أيضاً امتيازاً لـ «يوسف بك الزين» والد النائب الحالي «عبد اللطيف الزين»، كان النبع يروي بالجاذبية منطقة النبطية بأكملها ويصل حتى حدود مدينة صيدا. وكانت الفلسفة في ذلك الحين، الاعتماد على الينابيع العالية لسقي المناطق المنخفضة.
في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات دخلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID (النقطة الرابعة)، وأدخلت فلسفة الضخّ، فأصبحنا نضخّ المياه من رأس العين على مستوى سطح البحر إلى مدينة بنت جبيل «صفّ الهوا» على ارتفاع 780 متراً، أو من نهر الليطاني إلى ارتفاع 820 متراً أسفل بلدة الطيبة من أجل إيصال المياه إلى بلدات الطيبة وشقرا وبلعويل وبرعشيت وغيرها من القرى المحيطة. ففي الأربعينيات كانت مصالح المياه امتيازات، أمّا في أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات فأصبحت مصالح مستقلّة، ومنذ بداية العام 2000 أصبحت منشآت عامة استثمارية للمياه، ولكن السؤال المطروح: هلّ طرأ أيّ تعديل أو أُدخل أيّ تطوير على هذا القطاع، والكلّ يُسلّم بأنّ المياه هي الحياة؟
جرت أوّل مقاربة للتخطيط الإستراتيجي في العام 2000 عُرفت بالخطّة العشريّة، وقيل حينها أنّ هذه الخطّة ستُنجز في سنة 2010. فقاموا بإنشاء «بركة» سُمّيت «سدّ شبروح»، بسعة 8,5 مليون م3، وأذكر إحدى الزيارات التي قمنا بها إلى المغرب في سنة 2004 مع زملائنا المدراء العامّين، وهنا لا أوجّه نقداً إلى وزارتنا وزميلنا الدكتور فادي قمير، ولكن فقط من باب المقارنة، لقد قمنا بزيارة أحد السدود في المغرب، كان قد أُنجز منه 500 مليون م3، وكانوا يقومون بالتخطيط لسدّ آخر سعته حوالى 5 آلاف مليون م3، مع العلم بأنّ كميّة الهواطل في المغرب معروفة. لقد فاقت تكلفة بركة «شبروح»، بحسب المعلومات، الـ 117 مليون دولار أميركي، ممّا يجعلها أغلى تخزين في العالم مقارنةً بالمتر المكعب.
أمّا جنوباً، فما هي كمية المياه المُتاح لنا استثمارها؟ أنا لا أريد العودة إلى الأعوام 1973 و1975 و1978 و1982 و1993 و1996 وعام التحرير في الـ2000 وحرب تموز 2006، حيث عانت مؤسّسات إدارة المياه في الجنوب الكثير خلال تلك الأعوام. حالياً 85٪ من المياه التي يتمّ توزيعها جنوباً هي مياه جوفيّة، وأغلب الآبار هي آبار عميقة، أي كلفة الضخّ منها أمر خيالي. فلكي نسحب مياه الـ artisan الموجودة في برك رأس العين، والتي هي مياه مُفَجَّرة طبيعياً على ساحل البحر وغير محفورة، إلى منطقة بنت جبيل يجب ضخّ المياه إلى ارتفاع 780 متراً، وعلى أربع مراحل: الأولى من رأس العين إلى صدّيقين، والثانية من صدّيقين إلى كفرا، ومن ثمّ إلى رميش وعيتا الشعب، وأخيراً إلى بنت جبيل والقرى المحيطة بها. وتجدر الإشارة إلى أنّه وخلال هذه المراحل إذا لم يوجد تنسيق في التيار الكهربائي في نقطة واحدة من النقاط الأربع وقعت المشكلة. ونحن ورِثنا فلسفة مفادها أنّه عندما تقع أي مشكلة في المياه علينا أن نحفر بئراً، فأصبح لدينا 300 بئر ارتوازي، تستنزف من الاحتياط الإستراتيجي الوطني ما يقارب الـ 90 مليون م3 سنوياً، الأمر الذي يمسّ الأمن القومي المائي، مع ما تتكبّده المؤسسة من أكلاف باهظة من إدارة وتشغيل وصيانة.
أريد أن أقارب ما لُحظ بالخطّة العشرية، أو في ما عُرف مؤخراً بالإستراتيجية الوطنية للمياه، والتي أُنجزت في العام 2012. فإذا أخذنا على سبيل المثال مشروع «ناقل 800» بمعزل عن النقاش حول نوعيّة المياه، وسأعتبر جدلاً أنّهم قاموا بتنظيف الحوض وأعطونا مياهاً صالحة للشرب وللريّ، مع أنني أشكّ أن تكون نوعية المياه صالحة، فحصّتنا من مياه الشفّة بموجب المراسيم النافذة تبلغ 20 مليون م3. وإذا أخذنا ناقل «بسري- أنان» الناقل الجنوبي، لأنّه من «أنان» هناك ناقل شمالي وناقل جنوبي، تكون أيضاً حصتنا ما بين 20 إلى 25 مليون م3. إنّ هذه الكمية التي تقارب الـ40 مليون م3 من المياه سنوياً توازي 50٪ من المياه التي نستنزفها من الحوض الجوفي الذي يجب الحفاظ عليه.
إنّ مياهنا الجوفية متجدّدة، ولكن الاستمرار بهذا النزف يعتبر كارثيّاً، ونحن كمؤسّسة نعرف الكمية التي نقوم بسحبها، ومن المستبعد أن يكون بإمكان أي مسؤول في إدارة مياه لبنانية أن يحدّد الكمية التي يسحبها من مياهه الجوفية، لأنّ لا أحد يعلم عدد الآبار المحفورة، وحالياً هناك دراسة تقوم بها الوزارة مشكورة حول مسح الآبار والمياه الجوفية وكيف يتمّ استنزافها. ولكن لا يمكن أن تصل هذه الدراسة لأكثر من نسبة 90٪ ممّا يوجد على أرض الواقع، لأنّ هناك أعداداً كبيرة من الآبار في المزارع وفي القصور حُفرت مع رخص ومن دون رخص. لدينا 300 بئر ارتوازي للمؤسّسة على مساحة 2000 كلم2 أي إذا احتسبنا عدد القرى والبلدات ضمن نطاق عمل المؤسّسة، فهناك قرى تحصل على بئر ونصف، فأصبح عدد الآبار أكثر من المطلوب، وهذا بدوره أمر مُكلف.
في المقابل، نحن نستطيع أن نحصل على 45 مليون م3 من المياه من مصدرين سطحيين، من دون استعمال سدّ «إبل السقي» أو سدّ «الخردلي»، ولا حتى كمية المياه التي هي من حقّ الدولة اللبنانية أن تأخذها من نهر الوزّاني، لأنّ اتفاقية «جونستون» تُقرّ بأنّه من حقّنا أن نأخذ سنوياً 53 مليون م3، بينما نحن لا نأخذ إلّا حوالى 3,5 مليون م3 من تلك المياه. لقد ذكر زميلنا المهندس وسام كنج بأنّنا وفّرنا 6 مليون دولار أميركي في فاتورة الكهرباء لأنّنا سقينا بالجاذبية من سدّ شبروح، فتصوّروا أنّ 8 ملايين م3 وفّرت لنا 6 مليون دولار، فكم يمكن أن توفّر لنا الـ 45 مليون م3 من فاتورة الكهرباء، وكم من الممكن أن تسهم هذه الكمية بالحفاظ على الحوض الجوفي الذي أصبح مُستنزفاً؟
يشتكي أهل «برج البراجنة» من نوعية المياه لديهم، كونها مالحة وكلسيّة، وذلك بسبب دخول مياه البحر إلى الحوض الجوفي، مع العلم أنّ الحفر ممنوع قانوناً تحت خط السكّة الموجود في المنطقة، وبالتالي عند دخول مياه البحر إلى الحوض الجوفي ستقع المشكلة الخطرة والكبيرة، لأنّه لا يمكن تحليتها مهما قمنا بإعادة شحن المياه. المنطقة الوحيدة في لبنان التي تقوم بإعادة شحن المياه هي قناة «الديشونية» على تقاطع «غاليري سمعان»، فهناك آبار عمقها على ما أعتقد حوالى 400 متر، وكلّ الفائض من قناة الديشونية يُسحب من ثلاثة آبار.
أمّا حول موضوع سوء الإدارة، فمؤسسات المياه منذ العام 1959 مصالح مستقلّة كان ملاكها مدير، ورئيس دائرة فنيّة، ورئيس دائرة إداريّة، ورئيس دائرة ماليّة، لكنّها وحتى العام 2000 لم يطرأ عليها أي تطوير إطلاقاً، فكلّ التقنيات التي أتاحتها العلوم لم تُستخدم في هذا القطاع نهائياً.
ختاماً، ظهرت بدعة العمال «غبّ الطلب» لتغطية العجز في الإدارة، ممّا أدّى إلى إرهاق الإدارة واستنزافها بغية تأمين المياه للمواطن، أضف إلى ذلك مشكلة الكهرباء التي هي أيضاً من أكبر العوائق أمام تأمين الخدمة للمواطنين. هذه صورة عامة عن مشاكل مؤسّسة مياه الجنوب، وفي اعتقادي أنّها مشاكل مشتركة بين أغلب مؤسّسات المياه في لبنان.