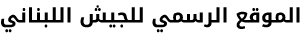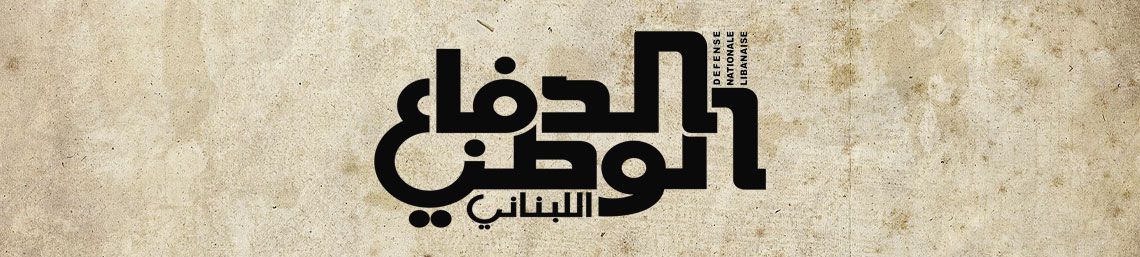- En
- Fr
- عربي
التاريخ العسكري في عصر الذكاء الاصطناعي: ثورة رقمية تُعيد كتابة الماضي
المقدمة
شهدت دراسة التاريخ العسكري، في السنوات الأخيرة، تحوّلًا ثوريًّا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد أتاحت الثورة الرقمية إمكانات غير مسبوقة لمعالجة كميات هائلة من الوثائق التاريخية بدقة وسرعة، ما أدى إلى فهمٍ أكثر عمقًا للحروب القديمة. لم تقتصر نتائج هذه الثورة على تحسين تحليل البيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك نحو مستويات معرفية أكثر تفصيلًا لم يكن الوصول إليها ممكنًا بالأساليب التقليدية. أصبح من الممكن اليوم، مثلًا، إعادة تمثيل الأبعاد النفسية والثقافية والعقائدية للمقاتلين، إلى جانب تحقيق فهم أدقّ للبيئة والمناخ والجغرافيا، وغيرها من العوامل التي أثّرت في مجريات المعارك. كما بات بالإمكان نقل المتعلّم، بفضل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، إلى قلب المعارك القديمة، حيث يرى مجريات القتال ويتفاعل مع الشخصيات التاريخية وكأنها تقف أمامه.
انطلاقًا من ذلك، يسعى هذا البحث، المؤلف من ثلاثة أقسام، إلى تحليل دور الذكاء الاصطناعي في دراسة وتعليم التاريخ العسكري. يتناول القسم الأول الإمكانات الثورية التي توفرها التقنيات الذكية في تطوير منهجيات البحث. يركّز القسم الثاني على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحديث طرائق التعليم. أما القسم الثالث، فيسلّط الضوء على التحديات المعرفية والأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات الذكية.
القسم الأول
إعادة كتابة التاريخ العسكري عبر أدوات الذكاء الاصطناعي
يُعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل المشهد البحثي في التاريخ العسكري بفضل أدوات تحليلية متقدمة تتجاوز الأساليب التقليدية. يتناول القسم الحالي هذا التحوّل من خلال أربعة محاور رئيسة. يبدأ التحليل أولًا برصد دور الذكاء الاصطناعي في إعادة قراءة الوثائق العسكرية القديمة واستنطاقها، ثم ينتقل إلى عرض التقنيات الثورية المستخدمة في الكشف عن مواقع المعارك التاريخية والأدوات المدفونة تحت الأرض. يتناول المحور الثالث إعادة بناء صورة المقاتل الذي عاش الحروب وخاضها في فترات تمتد إلى مئات، بل آلاف السنين. ويُختتم الفصل بتحليل أثر البيئة والمحيط والظروف المناخية في مجريات المعارك القديمة.
أولاًً: الرقمنة وإعادة قراءة الوثائق العسكرية
شهدت دراسة الوثائق العسكرية التاريخية تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، انتقلت فيها من الاعتماد الكامل على المعالجة اليدوية إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي. يعرض هذا البند أربعة محاور رئيسة توضح أبعاد هذا التحول، بدءًا برقمنة الوثائق الورقية التاريخية، مرورًا بالتحديات التي تواجه التعرف الآلي على النصوص، وصولًا إلى استخدام أدوات التحليل الشبكي والدلالي، وانتهاءً بدراسة حالة تطبيقية توضح الإمكانات العملية لهذا النمط الجديد من البحث.
1- تحويل الأرشيف الورقي إلى ذاكرة رقمية
تبدأ عملية تحويل الأرشيف الورقي إلى ذاكرة رقمية، برقمنة الوثائق الورقية عبر استخدام أدوات تصوير عالية الدقة. تتيح هذه العملية حفظ أدق التفاصيل المطبوعة أو المكتوبة على الوثيقة، مثل الأختام الرسمية والخطوط القديمة. تخضع الصور بعد ذلك، إلى معالجة بصرية متقدمة لتحسين جودتها وإزالة البهتان أو التشوهات الموجودة في الورق. يتم إثراء هذا العمل بإنشاء بنية رقمية منظمة للأرشيف، تسمح بتصنيف الوثائق وفق معايير زمنية وموضوعية دقيقة. تتحول الوثيقة العسكرية بهذه الطريقة إلى مادة قابلة للقراءة البرمجية والتحليل العميق بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي1.
2- التحليل الذكي: قراءة ما بين السطور
يبدأ تحليل الوثائق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بعد تحويلها إلى نصوص رقمية. يساعد ذلك في كشف معلومات لا يمكن الانتباه إليها باستعمال الطرق التقليدية في البحث. يكشف هذا التحليل معطيات كثيرة عن العلاقات بين الشخصيات العسكرية والمدنية والدينية، من خلال ربط الرسائل والأوامر والتقارير بعضها ببعض. يساعد ذلك في تحديد الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بالنفوذ والقرار داخل المؤسسات المعنية. يسمح تحليل النصوص أيضًا بتتبّع تطور الخطاب العسكري نفسه؛ وكيف استُخدمت مصطلحات لافتة كـ«الولاء» و«الخيانة» و«النصر» في الجملة، وما الذي كانت تعنيه فعليًا في سياقها الزمني والثقافي. بهذه الطريقة، لا تُقرأ الوثائق فقط كمجرد سجلات للماضي، بل تتحول إلى نوافذ لفهم العقليات والدوافع وتحوّلات المفاهيم العسكرية بمرور الزمن.
3- الوثائق الفنية تخبر قصص المعارك
ليست الوثائق الفنية، بمختلف أشكالها، مجرد تعبيرات جمالية، بل هي أيضًا وثائق تاريخية تحمل الكثير من المعلومات2. في هذا السياق، ومع تطور أدوات التحليل الرقمي، أصبح من الممكن استخراج الكثير من المعطيات من هذه الوثائق كطبيعة التضاريس الظاهرة في الوثيقة وأنماط توزيع المقاتلين والظروف المناخية المسيطرة. على سبيل المثال، تُعد لوحة «The Battle of Waterloo» التي رسمها ويليام سادلر الثاني في القرن التاسع عشر مصدرًا بصريًا غنيًا لفهم مشهد المعركة (صورة رقم 1). تُصوّر اللوحة اللحظات الحاسمة من الاشتباك بين قوات نابليون وجيوش الحلفاء وتظهر فيها كثافة الدخان والاشتباك القريب بين الجنود والخطوط التنظيمية لكل جيش.
4- دراسة حالة: أرشيف البندقية
يمثّل مشروع أرشيف مجلس العشرة في البندقية، الذي يتم تنفيذه حاليًا، مثالًا بارزًا على دور الذكاء الاصطناعي في دراسة الأرشيفات العسكرية4. شكّل هذا المجلس مركز القرار الأمني والعسكري للبندقية لعدة قرون، وخلّف وراءه أرشيفًا ضخمًا يتضمن مراسلات وأوامر ومحاضر استجواب تغطي فترة طويلة من الزمن. يقوم المشروع على رقمنة هذا الأرشيف، وتطبيق خوارزميات تعلّم آلي لتصنيف الوثائق بحسب نوعها ومضمونها. إحدى النتائج اللافتة لهذه العملية تمثلت في تتبع التغير في الخطاب السياسي والعسكري بعد حرب كيودجا5، حيث كشفت أدوات التحليل عن تزايد استخدام مفردات مرتبطة بالعقاب والخيانة والعنف، ما يعكس تحوّلاً في الذهنية السياسية تجاه الأمن والاستقرار. هذه الحالة تبيّن كيف يمكن للأدوات الرقمية أن تكشف تحولات عميقة لم يكن من الممكن إدراكها بسهولة عبر القراءة التقليدية6.
ثانيًا: التكنولوجيا الذكية لاكتشاف التراث العسكري
يشكل التراث الأثري العسكري جزءًا مهمًا من ذاكرة الحضارات، إذ يُوثّق صراعاتها، وتطوراتها التقنية واستراتيجياتها الدفاعية والهجومية. يتناول هذا البند أربعة محاور رئيسة توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التراث العسكري المدفون وتصنيف القطع الأثرية وتحليل المواقع عبر الاستشعار عن بعد وتوجيه البحث بواسطة النماذج التنبؤية.
1- تقنية LIDAR لكشف التراث العسكري المدفون
تُعد تقنية 7LIDAR من الأدوات الأكثر تطورًا في علم الآثار الحديث، خصوصًا في حالات يصعب فيها الحفر المباشر بسبب الغطاء النباتي الكثيف أو التضاريس الوعرة. تقوم هذه التقنية عبر جهاز مثبت على مسيّرة، بإرسال نبضات ليزر باتجاه سطح الأرض. يسجل الجهاز المدة التي تستغرقها هذه النبضات للعودة بعد ارتدادها. يسمح ذلك بإنشاء نماذج طوبوغرافية دقيقة تكشف عن تفاصيل قد تكون مخفية تحت التربة أو الغطاء النباتي. من أبرز الأمثلة على نجاح استخدام هذه التقنية، الدراسة التي أجراها فريق دولي عام 2018 في غابات غواتيمالا، حيث كشف الباحثون عن مئات المنشآت الأثرية التي تعود لحضارة المايا (صورة رقم ٢). شملت هذه المنشآت تحصينات عسكرية معقدة مثل الحصون والمتاريس والأسوار الدفاعية. تعكس هذه النتائج مدى تطور البنية التحتية العسكرية لتلك الحضارة، والتي كان من الصعب اكتشافها دون اللجوء إلى هذه التقنية المتقدمة8.
2- قراءة تاريخ القطع العسكرية
تُستخدم التقنيات الذكية في تحليل الصور الرقمية لقطع أثرية عسكرية مثل الخوذات والدروع والأسلحة البيضاء والفخاريات ذات الرموز الحربية. تُستخلص من هذه القطع خصائص دقيقة تشمل النقوش والزخارف والشكل الهندسي. يسمح ذلك بتصنيفها ودراستها لمعرفة خصائصها ووجهة استخدامها. أظهرت إحدى الدراسات فعالية هذا النهج، حيث طوّر الباحثون نموذجًا هجينًا للتعرف على الأجسام العسكرية من خلال دراسة صور 16 فئة مختلفة من المعدات العسكرية. مكّن هذا النموذج الباحثين من التعرف على الأجسام أو العناصر العسكرية (مثل الدبابات، الطائرات، الأسلحة...) من خلال تحليل صورها الرقمية. تبرز أهمية هذه التقنية في دراسة المواقع القديمة، حيث يُطلب التعرف السريع والموثوق على الأجسام العسكرية في الصور الجوية أو صور الأقمار الاصطناعية. تساهم هذه التحليلات، بالتالي، في بناء فهم أدقّ للبنية والتنظيم العسكري في الحضارات القديمة، من خلال إمكانية توظيف هذه النماذج لتفسير خصائص القطع المكتشفة ميدانيًا بطريقة علمية سريعة ودقيقة10.
3- إعادة بناء المنشآت العسكرية بتقنيات رقمية
يُعتبر الاستشعار عن بُعد، من خلال أدوات مثل الطائرات بدون طيار، والتصوير الحراري، وسيلة حيوية لإعادة إحياء المواقع العسكرية القديمة دون المساس بالبنية الأرضية. تُستخدم هذه الوسائل لإنشاء خرائط دقيقة ونماذج ثلاثية الأبعاد للمواقع العسكرية. يساعد ذلك في دراسة توزيع المنشآت أو المدن المحمية بأسوار، وتحديد الطرق المؤدية إليها وإظهار نقاط القوة والضعف في التحصينات. في جبيل مثلاً، استُخدمت الصور الجوية، والخرائط الطوبوغرافية، ونتائج الحفريات الأثرية لإعادة بناء رقمية للمدينة التاريخية عند إنشائها في أواخر الألفية الرابعة ق.م. (صورة رقم ٣). قدّمت هذه التقنية الرقمية فكرة واضحة عن شكل المدينة القديمة، وعن طبيعة الأسوار الدفاعية المحيطة بها، ومواقع بواباتها، ونقاط المراقبة المثالية لحمايتها، وخطوط الهجوم المحتمل عليها11.
4- التنبؤ بأماكن المواقع الأثرية
يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات ضخمة من البيانات الجغرافية والتاريخية والمناخية بهدف تحديد الأماكن الأكثر احتمالًا لوجود آثار غير مكتشفة. هذه الخوارزميات تحلل أنماط أماكن المواقع الأثرية المكتشفة سابقًا، وتُسقطها على خرائط حالية، فتقترح مناطق جديدة قد تحوي منشآت أو قطعًا أثرية. تُظهر تجربة الصين في صحراء جوبي مثالًا ناجحًا على تطبيق هذه التقنية، حيث تم استخدام نماذج تنبؤية لتحديد مواقع أثرية مرتبطة بسلالة تانغ (618-907 م). نجحت هذه التقنية في توجيه البعثات الأثرية إلى مستودعات أسلحة ومراكز مراقبة كانت مجهولة، ما ساهم بتوفير سنوات من العمل الميداني العشوائي12.
ثالثًا: المقاتل عبر العصور: قراءة جديدة بوسائل حديثة
لم يعد التاريخ العسكري يُقرأ اليوم من منظور الأسلحة والخطط والاستراتيجيات وحدها، بل أصبح الجندي المقاتل في صلب التحليل. من هو هذا المقاتل؟ كيف عاش؟ ماذا أكل؟ كيف فكّر؟ كيف تحرّك في ساحة القتال؟ وكيف تفاعل مع بيئته وعقيدته وثقافته؟ للإجابة على هذه الأسئلة، بات الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها، إذ يمكّننا من إعادة بناء الصورة الشاملة للمقاتلين عبر العصور، بالاعتماد على تحليل الحمض النووي والسلوك الميداني والذهنية العسكرية والمعطيات الثقافية.
١- دراسة بيولوجية للمقاتل
يساعد الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل رفات الجنود القدماء لرسم صورة دقيقة عن بنيتهم الجسدية وحالتهم الصحية وطبيعة تغذيتهم وإصاباتهم في القتال. تسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي، المدمجة بعلوم الطب الشرعي، بإعادة بناء الأوضاع الصحية للجيوش، وتحديد مدى استعدادهم البدني للحرب. كشفت إحدى الدراسات البارزة التي أجريت على رفات جنود معركة تاوتون عن حالات سوء تغذية مزمن وهشاشة عظام وأمراض مزمنة سبقت المعركة13. يعني ذلك أن الجنود دخلوا ساحة القتال أساساً في ظروف بيولوجية غير مثالية. مع هذه التقنيات تصبح رفات الجنود وثيقة طبية حية تُقرأ بأدوات حديثة لتعيد الحياة للصراعات الماضية14.
٢- الذهنية العسكرية في المعركة
يستخدم الذكاء الاصطناعي تقنيات متقدمة لتحليل النصوص التاريخية والرسائل والمذكرات وسجلات المعارك لاستخلاص الأنماط النفسية والسلوكية للمقاتلين. على سبيل المثال، تم استخدام خوارزميات لتحليل مراسلات نابليون وارتباطها بسياق المعارك التي خاضها، فبيّنت النتائج أن حالته النفسية والجسدية لا سيما في معركة واترلو 1815 م. قد تكون أثّرت بعمق على قراراته المصيرية وساهمت في خسارته للمعركة. ننتقل بذلك من تحليل الحرب كحدث، إلى تحليلها كمنظومة عقلية ونفسية تتفاعل فيها الإرادة والقرارات مع الضغط النفسي والجسدي الذي يعيشه القادة والمقاتلون15.
٣- الأداء الميداني للمقاتل
يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبّع وتحليل الأداء الميداني للجنود في قلب المعركة، عبر بناء نماذج محاكاة افتراضية تعيد تمثيل تحركاتهم وردود أفعالهم وتفاعلاتهم مع المتغيرات الآنية. إن دراسة حركة المقاتل في المعركة بالاستناد إلى بيانات مختلفة مثل حالة الطقس والموقع الجغرافي والحالة الجسدية والنفسية، تظهر أنّ الكثير من التصرفات الميدانية هي ذات طابع فردي، لا تنفيذي فقط. على سبيل المثال، تمّ استخدام تقنيات متقدمة لإعادة بناء الأصوات المحيطة في معركة جيتيسبيرغ16. أظهرت النتائج التأثير النفسي الكبير للأصوات في سلوك المقاتلين، سواء من ناحية الخوف أو الحماسة. تتحوّل المعركة استنادًا إلى هذه المقاربة إلى سلسلة قرارات بشرية معقّدة تُقرأ في ضوء العقل والجسد والتفاعل البيئي17.
٤- البعد الثقافي للمقاتل
أصبح من الممكن، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحليل السرديات والدعاية العسكرية لفهم الأبعاد الثقافية والرمزية التي شكّلت عقيدة المقاتلين. فقد بيّنت أبحاث معاصرة أن الخطاب السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية لم يكن مجرد وسيلة للتحفيز المعنوي، بل ساهم بشكل منهجي في صياغة «هوية المقاتل» السوفياتي على أساس سردية قومية شبه مقدسة. أظهرت تحليلات الخطاب والدعاية أن المقاتل لم يُقدَّم فقط كمجرد حامل للسلاح، بل كرمز للتضحية التاريخية، ووريث لمهمة مقدسة في الدفاع عن أرض الوطن ضد «العدو الفاشي». هذا ما تجسّد بشكل بارز في حدث رفع العلم فوق الرايخستاغ ببرلين 1945، حيث تحولت اللحظة العسكرية لاحقًا إلى رمز ثقافي وسياسي ودعائي خالد، مثّلت انتصار القيم الجماعية على الفاشية18 (صورة رقم ٤).
رابعًا: المحيط والجغرافيا والمناخ: عناصر حاسمة في القتال
يشكّل المحيط الطبيعي عاملاً حاسمًا في فهم المعارك التاريخية وتفسير مجرياتها. لقد أتاح الذكاء الاصطناعي للباحثين أدوات دقيقة لتحليل تأثير هذا العامل على القرارات الميدانية. في هذا السياق، يتناول هذا البند أربعة عناصر رئيسة للمحيط ساهمت في تشكيل المشهد القتالي: أولًا الطوبوغرافيا والتضاريس، ثانيًا العوامل الفلكية والزمنية، ثالثًا الطقس والمناخ، ورابعًا البنية التحتية واللوجستية.
١- الطوبوغرافيا والتضاريس
أثبت الذكاء الاصطناعي فاعليته في إعادة تشكيل الشكل الطوبوغرافي لأرض المعركة ضمن نماذج ثلاثية الأبعاد. يمكن لذلك أن يسمح بفهم العمق الجغرافي للمعارك بشكل لم يكن ممكنًا في السابق. من خلال معالجة بيانات الارتفاع والانحدار ونمذجة الغطاء النباتي والممرات الطبيعية، يمكن للباحثين الآن إعادة تصوّر كيفية تحرّكات الجيوش عبر الميدان وأين تمركزت ولماذا اختارت مواقع تمركزها. هذه النماذج لا تكتفي بإظهار المواقع، بل تُظهر أيضًا كيف تمّ استغلال التلال والوديان والأحراج والسهول لصالح المعركة. إن إعادة بناء معركة مثل «كان» بقيادة هنيبعل، لم تعد تعتمد فقط على وصف المؤرخين، بل على تحليل مكاني دقيق يفسّر التكتيكات الميدانية من خلال علاقتها بالبيئة الجغرافية20 (صورة رقم 5).
٢- العوامل الفلكية والزمنية
لا يمكن إغفال أهمية العوامل الزمنية والفلكية في سير الحروب، فقد لعبت الشمس والقمر دورًا غير مباشر لكنه فعّال في تحديد توقيت الهجوم أو الانسحاب في العديد من المعارك التاريخية. من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن اليوم إعادة تشكيل شكل السماء في لحظة تاريخية معينة، وتحديد موقع الأجرام السماوية في وقت المعركة. هذه المحاكاة تسمح بفهم كيف استُخدمت ظاهرة الشروق أو الغروب لتعمية العدو، أو كيف شكّلت الليالي القمرية غطاءً مناسبًا للتحرك الليلي. في معركة نهر غرانيكوس مثلًا شنّ الإسكندر المقدوني هجومه في فترة ما بعد الظهر، عندما كانت الشمس تلمع في الأفق مقابل صفوف الجنود الفرس. أدّى ذلك إلى انبهارهم وساهم في إخفاقهم. هذا النوع من التحليل يجعل من العوامل الزمنية والفلكية جزءًا من المشهد التكتيكي وليس مجرّد خلفية طبيعية22.
٣- الطقس والمناخ
يُظهر الطقس والمناخ تأثيرًا مباشرًا على القرارات العسكرية والعمليات الحربية. فالأمطار الغزيرة والعواصف الرملية والضباب الكثيف، لم تكن عوائق طبيعية فحسب، بل كانت عناصر تؤثر في مدى الرؤية وكفاءة الأسلحة وحركة القوات. باستخدام بيانات الأرشيف المناخي وصور الأقمار الاصطناعية، يمكن تتبع التغيرات المناخية أثناء الحملات الكبرى، مثل حملة نابليون على روسيا، أو المعارك التي دارت في السهول الأوروبية خلال الحربين العالميتين. دراسة هذه الأنماط المناخية لا تُظهر فقط الصعوبات البيئية، بل تكشف أيضًا عن قرارات استراتيجية بُـنيت على فهم دقيق أو على تجاهل لعوامل الطقس.
٤- البنية التحتية واللوجستية
تكشف تحليلات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالبنية التحتية والموارد اللوجستية عن أهمية موقع المعارك. فعبر تحديد مواقع الأنهار والعيون والطرق القديمة والمخازن، يمكن فهم كيف جرى وضع خطط الحملات العسكرية لضمان الإمداد والتموين. إن تحليل شبكات الطرق ومدى ارتباطها بالمواقع العسكرية يوضح كيف نُقلت الجيوش وأين أقيمت نقاط التمركز وما هي العوائق اللوجستية التي واجهتها. كما أن هذه النماذج تمكّن من محاكاة خيارات النقل في بيئات مختلفة، سواء في الصحراء أو الغابة أو المناطق الجبلية. إن فهم البنية التحتية هو جزء أساسي من تحليل فعالية أي حملة عسكرية تاريخية.
القسم الثاني
التقنيات الذكية الثورية في تعميم المعرفة المتعلقة بالتاريخ العسكري
أحدث الذكاء الاصطناعي اليوم تحوّلًا جذريًا في أدوات تعميم المعرفة في حقل التاريخ العسكري. يتناول القسم الحالي هذا الأمر من خلال أربعة محاور رئيسة. يعرض المحور الأول دور تقنيات المحاكاة الذكية في نقل المتعلم إلى قلب الأحداث التاريخية. يناقش المحور الثاني سبل التفاعل الذكي مع المحتوى الرقمي، ما يوفّر بيئة تعليمية ديناميكية. أما المحور الثالث، فيستعرض مبدأ التعلّم التكيّفي، حيث تُضبط المسارات التعليمية استنادًا إلى مستوى الطالب وسرعة استيعابه. يُختتم القسم بتحليل أهمية القراءة النقدية للتاريخ العسكري، ما يمكّن المتعلمين من فهم أعمق للقرارات الحربية بدلًا من الاكتفاء بالسرد الزمني للأحداث.
أولاًً: المحاكاة التاريخية الذكية للأحداث
باتت تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، في عصر الثورة الرقمية، أدوات فعالة في إعادة إحياء الماضي23. لم تعد دراسة التاريخ تقتصر على قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام الوثائقية، بل أصبحت تجربة حية تنقل المستخدم إلى قلب الحدث. في هذا السياق يسلط هذا البند الضوء على تقنيات الواقع الافتراضي والعروض الضوئية التفاعلية والخرائط ثلاثية الأبعاد وتجارب الواقع المعزز.
١- تقنية الواقع الافتراضي
يهدف استخدام الواقع الافتراضي في إعادة بناء المعارك إلى توفير تجربة حية تتجاوز السرد النظري. تعتمد هذه التقنية على جمع بيانات دقيقة من المصادر التاريخية، مثل الخرائط والوثائق وطبيعة الأسلحة المستخدمة، لإنتاج مشاهد ثلاثية الأبعاد. يتمثل التحليل المنطقي هنا في أن الدمج بين التاريخ والتقنية يعزز من ترسيخ المعلومات لدى المتعلم، من خلال تنشيط الذاكرة البصرية والحسية. فعوضًا عن تخيّل ما حدث في معركة مثل «واترلو»، يستطيع المستخدم عيشها لحظة بلحظة. أحد الأمثلة على ذلك هو فيديو تفاعلي بزاوية 360 درجة تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك يُمكّن المشاهد من الانغماس في أجواء هذه المعركة24.
٢- العروض الضوئية التفاعلية
في تقاطع بين الفن المسرحي والتكنولوجيا، برزت العروض الضوئية التفاعلية كوسيلة مبتكرة لإحياء المعارك التاريخية أو لإعادة بناء رقمية للقلاع وللتحصينات القديمة. باستخدام تقنية الإسقاط الضوئي (Projection Mapping)، تتحول الجدران إلى شاشات ضخمة تنقل مشاهد درامية من التاريخ، مدعومة بالصوت والموسيقى والمؤثرات البصرية. تعتمد هذه العروض على سرد بصري وسمعي يُحاكي الحدث التاريخي وكأنه عرض مسرحي حيّ. من أبرز الأمثلة على ذلك، العرض الليلي الذي يُقام سنويًا في مدينة كارسون الفرنسية عند أسوار قلعـة «Les Baux-de-Provence»، حيث يتم عرض معركة قديمة باستخدام إسقاطات ضوئية عملاقة مصحوبة بسرد حيّ (صورة رقم 6)25.
٣- خرائط تفاعلية ثلاثية الأبعاد
تُعد الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد من الوسائل المبتكرة لفهم السياقات الجغرافية والتكتيكية للمعارك التاريخية. هذه الخرائط لا تكتفي بعرض المواقع والمسارات فحسب، بل تُتيح للمستخدمين التفاعل مع عناصرها. مثلًا يمكن تحريك الجيوش واستعراض تغيرات المواقع عبر الزمن وتحليل التضاريس وتأثيرها على سير المعركة. تعتمد هذه الخرائط على بيانات دقيقة مستمدة من الوثائق التاريخية والاستشعار الجغرافي. كما وتُدمج في واجهات سهلة الاستخدام، سواء على الشاشات أو في بيئات الواقع الافتراضي. من الأمثلة الرائدة على هذا التوجه، منصة «Esri StoryMaps» واستخدام الباحثين لها لإعادة رسم معركة العلمين في الحرب العالمية الثانية، بحيث يمكن للمستخدم استكشاف التحركات العسكرية لحظة بلحظة، ومعرفة كيف ساهمت الكثبان الرملية والطرقات في تحديد نتائج المعركة26.
٤- تجارب الواقع المعزّز
يتميز الواقع المعزز بقدرته على دمج المحتوى الرقمي مع المواقع التاريخية. يمنح ذلك الزائر فرصة فريدة لمعاينة الحدث التاريخي في مكان حدوثه الأصلي. من خلال هاتف ذكي أو نظارات مخصصة، يمكن للمستخدم رؤية مشاهد وأشخاص وأحداث من الماضي تظهر أمامه وكأنها حقيقية. هذه التجربة لا تقتصر على الإبهار البصري، بل تُعزز أيضًا من الارتباط العاطفي والمعرفي بالمكان، إذ يتحول الزائر من متلقٍ سلبي إلى مشارك فعّال في السرد التاريخي. مثال على ذلك ما قامت به مؤسسة ARtGlass في موقع بومبي الأثري في إيطاليا، حيث وفّرت تجربة واقع معزز تُظهر الحياة اليومية في الشوارع والساحات والمعابد، مدعومة بمرشد صوتي تفاعلي يشرح السياق التاريخي بشكل متكامل27.
ثانيًا: الأدوات التفاعلية الذكية لتعليم التاريخ العسكري
يُمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية محفّزة. يتناول البند الحالي هذا الموضوع ضمن أربعة محاور رئيسة: الحوارات مع الشخصيات التاريخية، إعادة تجسيد القادة والمحاربين القدامى بالصوت والصورة، استخدام الألعاب الاستراتيجية التعليمية، واعتماد نظام المكافآت والتحديات التعليمية.
١- الحوارات مع الشخصيات التاريخية
أصبح من الممكن اليوم استخدام الذكاء الاصطناعي لتجسيد شخصيات تاريخية بطريقة تحاكي الواقع، بحيث يتمكّن الطلاب من «التحدث» مع هذه الشخصيات كما لو كانت على قيد الحياة. يتم ذلك من خلال برامج متطورة قادرة على إنتاج نصوص تُشبه أسلوب كلام الأشخاص الحقيقيين، سواء من حيث اللغة أو المضمون أو الخلفية التاريخية. موقع Character.AI هو مثال على ذلك بحيث يتيح للمستخدمين التحدث مع شخصيات تاريخية مُصمَّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن للطالب أن يسأل نابليون بونابرت عن دوافعه في معركة واترلو. هذه المحادثات تُعدّ تجربة تعليمية تفاعلية تساعد على تعميق الفهم بأسلوب ممتع وغير تقليدي28.
٢- إعادة تجسيد المحاربين القدامى بالصوت والصورة
أصبح من الممكن الآن ليس فقط «التحدث» إلى الشخصيات التاريخية، بل رؤيتها والتفاعل معها بصريًا وصوتيًا، وكأنها تقف أمامنا. تستخدم هذه التقنية مزيجًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، لإعادة إحياء ملوك وقادة عسكريين ومحاربين من العصور القديمة. من خلال تحليل الصور والنقوش والوثائق التاريخية، يتم إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة لهذه الشخصيات، يتم تدريبها على التحدث بلغتها الأصلية أو بلغة مفهومة حاليًا، مع الحفاظ على أسلوبها ومواقفها التاريخية. هكذا، يمكن للطالب أن يرى الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر وهو يشرح خططه العسكرية أو أن يتفاعل مع محارب أشوري يُحدّثه عن تدريبه وأسلحته (صورة رقم 7).
٣- الألعاب الاستراتيجية التعليمية
تُستخدم الألعاب الاستراتيجية كأداة تعليمية فعالة، حيث تُحفّز التفكير النقدي وتُعزز مهارات حل المشكلات. تصمم هذه الألعاب لتقديم محتوى تعليمي في إطار تفاعلي ممتع، مما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر على نتائج الأحداث. من خلال التفاعل النشط مع الألعاب، يُمكن للطلاب تعزيز فهمهم للتاريخ وللسياسة. على سبيل المثال، لعبة Mission US هي لعبة تعليمية تفاعلية موجهة للطلاب، تحاكي أحداثًا من التاريخ الأميركي. في كل مرحلة، يتقمّص اللاعب شخصية حقيقية من فترة تاريخية معينة، ويتخذ قرارات تؤثر في مجرى الأحداث. هذا النوع من التفاعل يُساعد الطلاب على فهم السياق التاريخي، والأفكار السياسية والاجتماعية في تلك الفترة، من خلال تجربة مباشرة30.
٤- نظام المكافآت والتحديات التعليمية
يُستخدم نظام المكافآت والتحديات لتحفيز الطلاب على المشاركة النشطة في العملية التعليمية. يُمنح الطلاب مكافآت عند إكمال مهام معينة أو تحقيق أهداف تعليمية محددة. يُعزز هذا النظام الدافع الذاتي لدى الطلاب ويشجعهم على الاستمرار في التعلم وتحقيق أهدافهم التعليمية من خلال تقديم حوافز ملموسة. على سبيل المثال، تُستخدم منصة Kahoot.com في المدارس والجامعات لتحفيز الطلاب من خلال الألعاب التعليمية. يحصل الطلاب عند مشاركتهم في الاختبارات أو المسابقات على نقاط حسب إجاباتهم وسرعتهم، ويظهر ترتيبهم في قائمة المتصدرين. يُحفّز هذا روح التحدي بينهم ويشجعهم على التعلّم بطريقة ممتعة وتفاعلية.
ثالثًا: التعلُّم التكيّفي الذكي
برز مفهوم «التعلم التكيّفي الذكي» كأحد الابتكارات التربوية الهامة في ظل التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم. وفقًا لذلك، لم يعد المحتوى التعليمي الخاص بالتاريخ العسكري ثابتًا لجميع المتعلمين، بل أصبح يتكيف مع قدراتهم واحتياجاتهم ومستوى تقدمهم. يهدف هذا البند إلى تحليل أربع ركائز أساسية لهذا النظام: تشخيص المعرفة المبدئية للطالب وبناء المسار التعليمي الديناميكي والتوصيات الذكية للمحتوى التاريخي وتعديل صعوبة المحتوى تلقائيًا.
١- تشخيص مستوى المعرفة للطالب
يشكّل تحديد مستوى الطالب نقطة الانطلاق لأي مسار تعلّمي فعّال لا سيما تدريس التاريخ العسكري. يتطلب الأمر فهمًا أوليًا لقدرة الطالب على قراءة الخرائط أو تحليل القرارات التكتيكية، أو التمييز بين السياقات الجغرافية المختلفة. تعتمد الأنظمة الذكية على اختبارات قصيرة تفاعلية أو أسئلة تحليلية تُقيس الخلفية التاريخية والعسكرية للمتعلم. هذا التشخيص يُـتيح للمدرّس أو للنظام الآلي تهيئة تجربة تعليمية تبدأ من المستوى الصحيح، ما يقلل من التكرار غير المجدي.
٢- بناء المسار التعليمي الديناميكي
تبدأ مرحلة بناء المسار الخاص بالطالب بمجرد تحديد مستواه. يتم توجيه المحتوى والتمارين والموارد التعليمية بطريقة غير خطية، تضمن أن يتعلّم كل طالب حسب تقدّمه الفردي ومع احترام أفضلياته. قد يتعمق أحد الطلاب في استراتيجيات حملات نابليون بونابارت، بينما يُفضّل آخر التركيز على الثورة الفرنسية من منظورها العسكري. يسمح هذا النظام للطالب القفز بين المراحل عند إظهار التقدّم. هذا المسار المتغير يُـتيح مزيدًا من المرونة، ويُقلل من الإحباط، ويعزز الشعور بالسيطرة الذاتية. مثلًا، تُتيح منصات الذكاء الاصطناعي للمتعلم تحليل معركة معينة أولًا من حيث النتائج، ثم الرجوع لفهم مقدماتها إذا ظهرت الحاجة لذلك.
٣- التوصيات الذكية للمحتوى التاريخي
لا يكتفي التعلّم التكيّفي بتعديل المحتوى فقط، بل يُقدّم للطالب توصيات في الوقت المناسب تساعده على تحسين أدائه أو تعميق فهمه. فعندما يُظهر النظام أن الطالب يواجه صعوبة في فهم تحركات الجيش العثماني خلال حصار فيينا مثلًا، يتم اقتراح فيديو تفاعلي يُظهر تحركات القوات على خريطة متحركة، أو يُوجهه إلى نص يشرح سياق التحالفات الأوروبية في تلك الفترة. هذه التوصيات تُبنى اعتمادًا على تحليل أنماط التفاعل وأخطاء الإجابات ومدة التوقف عند كل موضوع. تساعد هذه المقاربة الطالب على بناء فهم متدرج ومتوازن للمادة، كما تخفف الضغط الناتج عن تراكم المعلومات.
٤- تعديل صعوبة المهام تلقائيًا
تختلف مستويات تعقيد المفاهيم من معركة لأخرى أو من منطقة جغرافية إلى أخرى في تدريس التاريخ العسكري. لذلك، يُعد التعديل التلقائي لصعوبة التمارين أحد أبرز ميزات النموذج الذكي المعتمد أو الذي يجب أن يعتمد في التدريس. عندما يُظهر الطالب تقدّمًا، يُعرض عليه محتوى أعمق مثل تحليل الفرق بين استراتيجيات الدفاع والهجوم في الحروب غير المتكافئة. وإذا واجه صعوبة، يُخفض مستوى التحدي، أو يُبسّط من خلال رسومات أو فيديوهات أو مقارنة بأحداث مشابهة. هذا التدرّج يحافظ على حماس الطالب ويقلل الإحباط.
رابعًا: التعلُّم من خلال التحليل النقدي
يمكن للتحليل النقدي أن يقوم بمقارنة البيانات التاريخية لإعادة قراءة الماضي بعيون أكثر دقة ووعيًا. يرتكز التحليل النقدي على أربع نقاط مترابطة: قراءة جديدة للهزائم وللانتصارات، نمذجة السيناريوهات البديلة، المقارنة الاستراتيجية، ومقاربة التاريخ على أنه ليس حقيقة مطلقة.
١- قراءة جديدة للهزائم وللانتصارات
عند تطبيق تقنيات تحليل البيانات على المعلومات التاريخية، تبرز أمام الدارسين أنماطٌ غير مرئية بالطرق التقليدية. مثلًا، تأثير أنظمة الاتصالات على تنسيق الهجمات أو دور العوامل اللوجستية في حسم المواجهات. تتيح هذه الأدوات التفاعلية محاكاة سيناريوهات بديلة تظهر كيف كان يمكن أن تتغير النتائج باختلاف القرارات أو الظروف. بهذه الطريقة، يصبح الطالب قادراً على تحليل الأحداث كخبير استراتيجي، وربط الدروس التاريخية بالتحديات العسكرية المعاصرة. على سبيل المثال، عند تحليل معركة واترلو (1815) باستخدام أدوات تحليل بياني متقدمة، تبين أن انقطاع الاتصالات بين وحدات جيش نابليون، نتيجة الطقس السيئ والطين الذي أعاق حركة المدفعية والخيالة، كان عاملًا حاسمًا في هزيمته، متجاوزًا التفسير التقليدي القائم على تفوق الحلفاء العددي فقط31.
٢- نمذجة سيناريوهات تاريخية بديلة
تُعد النمذجة الافتراضية للأحداث التاريخية أداة تعليمية فعّالة تُستخدم لاستكشاف تأثير القرارات البديلة في لحظات حاسمة من التاريخ. بدلاً من الاقتصار على سرد الوقائع، تعتمد هذه المنهجية على طرح تساؤلات من نوع «ماذا لو؟»، مما يُسهم في الكشف عن العوامل الحاسمة التي شكّلت مجرى الأحداث32. تُوظّف هذه النماذج خوارزميات محاكاة تُدخل تعديلات مدروسة على سيناريوهات واقعية، فتُعيد بناء النتائج المحتملة وفقًا لذلك. على سبيل المثال، يمكن إجراء تطوير نموذج محاكاة افتراضي لمعركة «تور» (732م) بين شارل مارتل وجيوش الدولة الأموية، حيث يُطلب من الطلاب تغيير موقع الاصطفاف العسكري أو توقيت الهجوم، وتحليل النتائج البديلة المترتبة عن تلك التعديلات (صورة رقم 8). من المتوقع أن تظهر التجربة أن التفاعل مع «السيناريوهات الافتراضية البديلة» يعزز الفهم النقدي للعوامل العسكرية والجغرافية والسياسية التي تحدد نتائج المعارك.
٣- مقارنة الاستراتيجيات العسكرية
تعتمد هذه المقاربة على مقارنة استراتيجيات عسكرية استخدمتها جيوش مختلفة في سياقات زمنية وجغرافية متنوعة، بهدف فهم نقاط القوة والضعف في كل استراتيجية. يشمل ذلك تحليل العقيدة القتالية واستخدام الموارد والتحركات اللوجستية والتكتيكات العملياتية. ما يجعل هذا التحليل بالغ الأهمية هو قدرته على كشف مدى ملاءمة كل استراتيجية لظروفها، وتبيان مدى تطور الفكر العسكري عبر العصور. مثلًا، عند مقارنة حملة الإسكندر الأكبر في آسيا مع حملة نابليون في مصر، نجد أن كليهما سعى إلى تحقيق الهيمنة الثقافية والاقتصادية، لكن الإسكندر اعتمد سياسة الدمج الثقافي والتقرب من الشعوب، بينما فضّل نابليون السيطرة بالقوة والدعاية. هذا التباين في النهج الاستراتيجي يكشف عن اختلاف في تصور العلاقة بين القوة العسكرية والسيطرة السياسية، ويساعد الدارس على إدراك تنوع أساليب الحرب وأهدافها.
٤- التاريخ ليس حقيقة مطلقة
لا يمكن التعامل مع النصوص التاريخية بوصفها مرايا صافية للوقائع، إذ غالبًا ما تكون محمّلة بتحيّزات وطنية أو إيديولوجية أو دينية. تعدد الروايات حول الأحداث العسكرية يشكل فرصة تعليمية ثمينة. من خلال مقارنة روايات الأطراف المختلفة لنفس المعركة، يتعلم الطلاب أن التاريخ ليس حقيقة مطلقة، بل بناءً تفسيرياً. يمكن للمعلمين تقديم وثائق أولية من وجهات نظر متعارضة، ثم توجيه الطلاب لتحليل الفروقات في التركيز واللغة المستخدمة والعناصر التي تم إبرازها أو إغفالها. هذه الممارسة تنمّي مهارات التحليل النقدي وتعلّم الطلاب تقييم المصادر التاريخية، كما تظهر كيف تؤثر الخلفيات الثقافية والسياسية على كتابة التاريخ.
القسم الثالث
التاريخ العسكري الذكي: التحديات وأفق التغيير
يُحدِث الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في دراسة التاريخ العسكري، لكنه يفرض تحدياتٍ منهجيةً تُعيد تعريف دور المؤرخ وضوابط البحث. يتناول القسم الحالي ذلك من خلال أربعة محاور رئيسة. يبدأ القسم برصد القيود التقنية والمنهجية التي قد تحدّ من قدرة هذه التقنيات على فهم النصوص والسياقات التاريخية، ثم ينتقل إلى مناقشة الإشكاليات الأخلاقية والمعرفية المرتبطة بإعادة بناء السرديات. يلي ذلك تحليل لدور المؤرخ في هذا السياق الجديد، مع التركيز على الحاجة إلى المهارات الرقمية. ويُختتم القسم برؤية استشرافية لأهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث.
أولاًً: القيود التقنية والمنهجية
يواجه الباحثون في التاريخ العسكري حاليًا وعند استعمال وسائل التكنولوجيا الذكية، مجموعة من التحديات التقنية والمنهجية. من أهم هذه التحديات نذكر ما يتعلق بموثوقية البيانات، وصعوبة التحقق من التفسيرات التاريخية، وانحياز الخوارزميات، بالإضافة إلى محدودية قدرة النماذج على فهم السياقات الثقافية والزمنية الخاصة بكل حضارة أو ثقافة أو فترة تاريخية.
1- الاعتماد على بيانات غير مكتملة
يعتمد الذكاء الاصطناعي بالكامل على ما يُقدَّم له من بيانات عندما يتعلق الأمر بالبحث التاريخي مما يشكل أحد أبرز العقبات التي تواجهه. تكون هذه البيانات غير مكتملة في كثير من الأحيان، إما بسبب الفقدان الطبيعي للوثائق بمرور الزمن، أو بسبب غياب التوثيق في بعض الفترات أو المناطق المهمّشة. عندما تُستخدم هذه المعطيات الجزئية في النماذج الذكية، تكون النتيجة استنتاجات غير دقيقة قد تعكس صورة مشوهة عن الماضي. فالنموذج الذي يعتمد على نصوص محفوظة من حضارة دون أخرى سيفشل حتمًا في تقديم قراءة متوازنة لتاريخ التفاعل بين الحضارات. وهنا تظهر الحاجة إلى تدخل الباحث الذي يملك أدوات نقد المصدر ويستطيع تقييم مدى تمثيلية المادة التاريخية المعالَجة.
2- صعوبة التحقق من التفسيرات التاريخية
تفتقر التفسيرات والسيناريوهات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إلى إمكان التحقق المنهجي من دقَّتها. لا يمتلك النموذج الحسابي الوعي الكافي لمقارنة المصادر أو اختبار صحة الروايات، بل يعمل على أساس احتمالات ناتجة عن التكرار الإحصائي للبيانات. قد يؤدي ذلك إلى ترسيخ تصورات معينة، حتى وإن كانت خاطئة، خاصة عندما تغيب المعايير النقدية في تقييم النتائج. ولأن التاريخ ليس فقط تجميعًا للوقائع، بل هو بناء معرفي معقد، فإن أي إغفال لتلك الجوانب يجعل من النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي غير كافية لبناء معرفة تاريخية سليمة.
3- الانحيازات الخوارزمية وتأثيرها على النتائج
تشكل الانحيازات المدمجة داخل الخوارزميات تحديًا آخر في التعامل مع الذكاء الاصطناعي في الدراسات التاريخية. فالنماذج الذكية يتم تدريبها على مجموعات من البيانات التي قد تعكس نظرة معينة للعالم أو تستبعد سرديات أخرى. يعني هذا أن الخوارزمية قد تعيد، دون قصد، إنتاج نفس الأنماط المنحازة التي تحتويها البيانات الأصلية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت معظم النصوص التاريخية المتاحة تتعلق بالغرب، فإن النموذج سيكون أكثر كفاءة في تحليل هذه المنطقة، في حين يعاني من قصور في التعامل مع مناطق مثل إفريقيا أو آسيا. وهكذا، فإن ما يبدو كموضوعية رقمية قد يخفي في الواقع تكرارًا لتحيزات بشرية سابقة.
4- ضعف فهم السياقات الزمنية والثقافية
لا يمكن تجاوز الجانب الثقافي والزمني في دراسة التاريخ، وهو ما يُشكل نقطة ضعف جوهرية في النماذج الذكية الحالية. فحتى إن تم تدريب الخوارزمية على عدد كبير من النصوص، فإنها لا تمتلك الإحساس الحقيقي بالسياق الذي كُتبت فيه هذه الوثائق. فهي لا تدرك الفروقات الدقيقة في اللغة، ولا تفهم القيم الرمزية التي قد تتغير عبر القرون، ولا تميز بين ما هو توصيفي وما هو تعبيري أو أيديولوجي في الخطابات التاريخية. إن هذا الافتقار إلى الفهم العميق للثقافات والسياقات الزمنية يجعل من الصعب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج تفسيرات تاريخية دقيقة. يفرض ذلك، مرة أخرى، أن تكون هذه الأدوات في خدمة الباحث، لا أن تحل محله.
ثانيًا: الإشكالية الأخلاقية والمعرفية
يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في دراسة التاريخ العسكري تساؤلات أخلاقية ومعرفية عميقة تتعلق بقدرته على تفسير الأحداث التاريخية، وبملكية السرديات التي يُعاد تركيبها، وبخطر استغلال نتائج الأبحاث لأغراض أيديولوجية، فضلاً عن القلق بشأن فقدان التعددية في التأويل لصالح رؤية واحدة تنتجها الخوارزميات.
1- معالجة التاريخ وليس تفسيره
يُعتبر التاريخ مجالًا غنيًا بالتفسيرات والتحليلات التي تتطلب فهمًا عميقًا للسياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية. يتمتع الذكاء الاصطناعي بقدرة عالية على معالجة كميات ضخمة من البيانات، إلا أنه يفتقر إلى القدرة على التأويل وفهم المعاني الضمنية التي تتجاوز البيانات الظاهرة. فهو يعتمد على الأنماط الإحصائية والتكرار في البيانات، مما يجعله غير قادر على تقديم تفسيرات جديدة أو فهم الدوافع الإنسانية وراء الأحداث التاريخية. يثير هذا أسئلة نقدية حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسات التاريخية.
2- ملكية السرديات التاريخية
تظهر مسألة ملكية السرديات التاريخية كإشكالية إضافية عند استخدام الذكاء الاصطناعي. هل تعود ملكية السرديات المقدمة من الذكاء الاصطناعي إلى مطوّري الخوارزميات، أم إلى المؤسسات التي توفر البيانات، أم إلى المجتمعات التي تمثلها هذه السرديات؟ ويبرز أيضًا سؤال آخر: هل يجوز قانونًا وأخلاقيًا احتكار روايات تاريخية تمثل تراثًا مشتركًا، لمجرد أنها أُعيد تركيبها عبر خوارزميات طُوّرت في بيئات معينة؟
3- خطر تشويه أو استغلال النتائج
يمكن أن تُستخدم نتائج الذكاء الاصطناعي في التاريخ لأغراض أيديولوجية أو دعائية، بخاصةٍ إذا تمّ توجيه الخوارزميات لتقديم تفسيرات تتماشى مع أجندات معينة. هذا الخطر يتضاعف في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى يبدو موضوعيًا ومحايدًا، بينما قد يكون في الواقع منحازًا أو مشوهًا. مثل هذا الاستخدام يمكن أن يؤدي إلى إعادة كتابة التاريخ بطريقة تخدم مصالح محددة، مما يقوّض الثقة في المعرفة التاريخية ويؤثر سلبًا على الوعي الجماعي.
4- تقويض الإبداع الطلابي
يُشكِّل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كتابة الأبحاث التاريخية خطرًا على التكوين الفكري والمهارات الأكاديمية للطالب. فعندما يستعيض عن جهده البحثي ببحث جاهز من الذكاء الاصطناعي، يفقد فرصة تطوير مهارات أساسية مثل: التحليل النقدي، والربط بين الأحداث، وتقييم المصادر، والتفكير المنطقي. كما أن الاعتياد على هذا النمط يُضعف قدرته على الكتابة الأكاديمية المستقلة، ويحدّ من إبداعه في صياغة الأفكار.
ثالثًا: دور المؤرخ في عصر الذكاء الاصطناعي
بات من الضروري إعادة تعريف دور المؤرخ، إذ تفرض تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أدوات تحليل قوية، لكنها تستدعي تدخلًا بشريًا لضمان تفسير نقدي للنتائج. من المهم التوضيح أن المقصود هنا ليس الآلات الذكية، بل النظم الرقمية التي تُعنى بتحليل البيانات الضخمة ومعالجة المعلومات البحثية. يتطلب هذا الواقع الجديد من المؤرخين تطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع علماء البيانات لتحقيق فهم أعمق للتاريخ.
1- أهمية الإشراف البشري
يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى الفهم العميق للسياقات التاريخية والثقافية رغم قدراته التحليلية المتقدمة. يأتي هنا دور المؤرخ في تقديم تفسير نقدي لما تقدمه التقنيات الذكية، معتمدًا على خبرته ومعرفته بالسياقات المختلفة. فالمؤرخ قادر على التمييز بين المعلومات الدقيقة والمضللة، وتحديد مدى صحة الفرضيات التي تقدمها الخوارزميات، مما يضمن تقديم سرد تاريخي موثوق ومتوازن.
2- إعادة تعريف المنهجية التاريخية
يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي في الدراسات التاريخية إعادة تعريف للمنهجية المتبعة. فبدلاً من الاعتماد الكامل على المصادر التقليدية، يجب أن تشمل المنهجية الجديدة استخدام أدوات تحليل البيانات والتعلّم الآلي. هذا التغيير لا يعني التخلي عن الأساليب التقليدية، بل يمثل تكاملًا بين الطرق القديمة والجديدة لتحقيق فهم شامل ومعمق للتاريخ.
3- تطوير المهارات الرقمية
أصبح من الضروري للمؤرخين تطوير مهاراتهم الرقمية في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة. يشمل ذلك التعرف على أدوات تحليل البيانات، وفهم كيفية عمل الخوارزميات، واستخدام البرمجيات المتخصصة في تحليل النصوص والمصادر التاريخية. يمكِّن هذا التطوير المؤرخين من التعامل بفعالية مع الكميات الهائلة من البيانات المتاحة، واستخلاص المعلومات القيّمة منها.
4- تعزيز التعاون بين المؤرخين وعلماء البيانات
يجب تعزيز التعاون بين المؤرخين وعلماء البيانات لتحقيق أفضل النتائج في دراسة التاريخ باستخدام الذكاء الاصطناعي. فبينما يمتلك المؤرخون الخبرة في تحليل السياقات التاريخية، يتمتع علماء البيانات بالمهارات التقنية اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات الكبيرة. يتيح هذا التعاون تبادل المعرفة والخبرات، مما يؤدي إلى نتائج أكثر دقة وشمولية في فهم الأحداث التاريخية.
رابعًا: الرؤية المستقبلية
رغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي في دراسة التاريخ العسكري لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن إمكاناته المستقبلية تثير تساؤلات عميقة: هل سيتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة أساسية لا غنى عنها؟ أم أن حدوده المعرفية والأخلاقية ستكبح انتشاره؟ في هذا النص، سنحاول استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال دراسة التاريخ العسكري، بين سيناريوهات التقدّم والاندماج المنهجي والتراجع أو حتى الرفض.
1- آفاق التطوّر التقني في خدمة البحث
في حال واصل الذكاء الاصطناعي تطوّره كما هو متوقع، فإننا قد نشهد في العقود القادمة انتقاله من أداة مساعدة إلى شريك فعّال في جميع الأبحاث. تطور النماذج اللغوية سيمكّنها، كما ذكرنا سابقًا، من قراءة الأرشيفات العسكرية الضخمة، بلغات متعددة، وتحليلها بسرعة تتجاوز قدرات البشر. قد يصبح الذكاء الاصطناعي إذًا، عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في صياغة الروايات العسكرية التاريخية وفهم ديناميات الصراع، مما يغيّر جذريًا أساليب البحث في هذا المجال. سيكون على المؤرخ أن يتعلّم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تحليل النصوص التاريخية، وبرامج اكتشاف الروابط بين الأحداث والأشخاص وغيرها.
2- الرؤية المستقبلية التعليمية للذكاء الاصطناعي
إذا استمرت وتيرة التطور التكنولوجي كما هو متوقّع، سيُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في طرائق تدريس التاريخ العسكري وفهمه. من المتوقع أن تصبح القاعات الدراسية مثلًا، أكثر تفاعلية، حيث تُستخدم تقنيات المحاكاة والتصور ثلاثي الأبعاد لإعادة تمثيل المعارك التاريخية. سيشارك الطلاب في تحليل السيناريوهات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية كما لو كانوا في قلب الحدث. كذلك، سيساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم الذاتي، واكتساب المعرفة من خلال التجربة التفاعلية والمحاكاة، عوضًا عن الحفظ والنقل السلبي للمعلومة. يُقبل التعليم التاريخي على تحوّل جوهري، تتداخل فيه التكنولوجيا مع المنهج النقدي، لصناعة جيل جديد من الباحثين يمتلك أدوات المستقبل.
3- مقاومة منهجية وأخلاقية محتملة
ليس من المستبعد أن يشهد الذكاء الاصطناعي تراجعًا في بعض السياقات الأكاديمية رغم آفاقه الواعدة. أحد أسباب ذلك قد يكون الرفض المبدئي لهيمنة الآلة على الذاكرة الإنسانية، بخاصة في مجالات شديدة الحساسية كالتاريخ العسكري، حيث تُمثل السرديات الرسمية عنصرًا من عناصر الهوية الوطنية. كذلك، فإنّ احتمال التلاعب السياسي أو الأيديولوجي بالخوارزميات لتوجيه قراءة معينة للتاريخ، قد يدفع بعض المؤسسات الأكاديمية إلى التشكيك في مصداقية هذا النوع من ”المعرفة الاصطناعية“. كما قد تؤدي محدودية فهم الآلة للسياقات الإنسانية المعقدة والرموز الثقافية العميقة، إلى إنتاج تأويلات ناقصة أو مغلوطة.
4- المستقبل بين التقدّم المشروط والاندماج النقدي
لا يكمن السيناريو الأكثر واقعية لمستقبل الذكاء الاصطناعي في سيطرته الكاملة على الأبحاث، ولا في استبعاده المطلق، بل في نوع من التوازن الواعي بين إمكاناته ومحدوديته. رغم القدرة الهائلة للأدوات الذكية على معالجة البيانات، لا يمكن أن تحلّ محل الحسّ التاريخي والتأويلي الذي يميّز العقل البشري. سيبقى دور المؤرخ محوريًا، ليس فقط بوصفه ”مُشرفًا“ على أداء الآلة، بل باعتباره الحامل لتقليد نقدي عريق يصعب استبداله. هكذا فقط يمكن أن يتحقق اندماج نقدي فعّال بين الإنسان والآلة، يحترم روح المعرفة الإنسانية ويستفيد من قوة التقنية في آنٍ واحد.
الخلاصة
أحدث الذكاء الاصطناعي تحوّلًا عميقًا في دراسة التاريخ العسكري، سواء على مستوى البحث أو على مستوى التعليم. على صعيد البحث، أصبح من الممكن تحليل كميات هائلة من الوثائق التاريخية بسرعة غير مسبوقة. لم تقتصر نتائج هذه الثورة على تحسين تحليل البيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك نحو مستويات معرفية أكثر تفصيلًا لم يكن الوصول إليها ممكنًا بالأساليب التقليدية. أصبح من الممكن اليوم، مثلًا، الكشف عن مواقع أثرية ومراكز عسكرية دفينة، ظلت بعيدة عن متناول الأبحاث التقليدية. كما بات ممكنًا دراسة حياة المقاتل عبر العصور من الناحيتين البيولوجية والنفسية، بالإضافة إلى تحليل تأثير العوامل البيئية والطقس على سير الحروب القديمة، وغير ذلك من القدرات الثورية.
ساهم الذكاء الاصطناعي، على صعيد التعليم، في إحداث نقلة نوعية في تجربة تعلّم التاريخ العسكري. لم يعد الطالب مجرد متلقٍ للمعلومة، بل أصبح مشاركًا فعّالًا ضمن بيئات محاكاة واقعية للمعارك والقرارات الحاسمة. سمحت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز بدورها بإعادة بناء مشاهد القتال لحظة بلحظة، ناقلةً بذلك الطالب إلى قلب الحدث. كما أتاحت المحادثات مع شخصيات تاريخية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي فهمًا أكثر عمقًا للأحداث. إلى جانب ذلك، وفّر التعلّم التكيّفي مساراتٍ معرفية شخصية، تعزّز استقلالية المتعلم وتراعي تفاوت قدراته.
في موازاة هذه القفزة التكنولوجية، ظهرت تحديات حقيقية تتعلّق بموثوقية الذكاء الاصطناعي في مجال البحث التاريخي. فالخوارزميات، رغم دقتها الحسابية، تبقى عاجزة عن الإحاطة بكل الثقافات أو الحضارات. كما أن اعتمادها على بيانات منقوصة أو منحازة يؤدي إلى إنتاج سرديات غير مكتملة. أضف إلى ذلك أيضًا أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والتحيّز دون إشراف بشري واعٍ. استنادًا إلى هذا الواقع، يخلص البحث إلى أن مستقبل دراسة التاريخ العسكري لا يقوم على استبدال الإنسان بالآلة، بل على بناء علاقة تكاملية بين الذكاء الاصطناعي والمنهج التاريخي النقدي. هذا التكامل، القائم على الاعتراف بحدود كل طرف، هو ما يضمن إنتاج معرفة أكثر دقة، ووفاءً للتجربة الإنسانية في الحروب والنزاعات.
نأمل في نهاية هذا البحث أن تشهد السنوات القادمة تعاونًا متكاملًا بين المؤسسات الأكاديمية والعسكرية والباحثين والمطوّرين، في دراسة وتعليم التاريخ العسكري. كما نأمل أن يُراعى في بناء الخوارزميات اختلاف السياقات الثقافية، لضمان عدالة التمثيل التاريخي وتجنّب التحيّزات. نذكر أخيرًا أنّنا لا ندّعي الإحاطة بجميع جوانب الموضوع في هذا العمل، نظرًا لتشعّبه وسرعة تطوّره. وعليه نتمنّى أن يشكّل هذا البحث منطلقًا لمزيد من الدراسات المتخصصة التي تغني هذا الميدان الحيوي وتواكب مستجداته.
المصادر والمراجع
مراجع عربية
1. الجلبوط، زياد. «حصار الإسكندر الأكبر لمدينة صور واحتلالها في العام 332 ق.م.» مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 105، ص ص 41–69.
2. عبدالحميد، ندا. «الأرشيفات الجارية بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالأجهزة الحكومية: دراسة تطبيقية على جامعة أسيوط»، المجلة العلمية للمکتبات والوثائق والمعلومات، المجلّد 5، العدد 13.2، 2023، ص ص 227–279.
مراجع أجنبية
1.Chipatiso, E. “Applications of GIS and Artificial Intelligence in Military Operations: Prospects and Challenges.” Space Science Journal, Vol 1, 2024, pp 1-7.
2.Colavizza, G., Ehrmann, M., & Bortoluzzi, F. “Index-Driven Digitization and Index-ation of Historical Archives.” Frontiers in Digital Humanities, Vol 6, 2019, pp 12–18.
3.Frederick, T., & Coman, A. “Reception of Great Patriotic War Narratives: A Psy- chological Approach to Studying Collective Memory in Russia.” Researching Mem-ory and Identity in Russia and Eastern Europe, 2022, pp 163–181.
4.Holst, M., & Sutherland, T. “Towton Revisited: Analysis of the Human Remains from the Battle of Towton 1461.” In Schlachtfeld und Massengrab: Spektren Interdiszi-plinärer Auswertung von Orten der Gewalt, 2014, pp 97–129.
5.Hudson, D. The Handy American History Answer Book. Visible Ink Press, Michigan, 2015.
6. Hutchinson, D. “The Causes of Napoleon Bonaparte’s Defeat at Waterloo 1815.” Journal of Military History, Vol 89, No 3, 2025, pp 45–72.
7.Jalbout, Z. “The First Defensive Systems at Byblos.” Byblos. A Legacy Unearthed, Netherlands, 2023, pp 75–80.
8. Murtha, T.M., et al. “Drone-Mounted Lidar Survey of Maya Settlement and Land-scape.” Latin American Antiquity, Vol 30, No 3, 2019, pp 630–636.
9.Schuurman, P. “What-If at Waterloo: Carl von Clausewitz’s Use of Historical Coun-terfactuals in His History of the Campaign of 1815.” Journal of Strategic Studies, Vol 40, 2017, pp 1–23.
10.Surrisyad, H.A. “Fast Military Object Recognition Using Extreme Learning Approach on CNN.” International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol 11, No 12, 2020, pp 210-220.
11.Wang, Y., Shi, X., & Oguchi, T. “Archaeological Predictive Modeling Using Machine Learning and Statistical Methods for Japan and China.” ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol 12, 2023, pp 1-27.
مراجع الكترونية
1. ArcGIS Group. "Instant Portfolio App – Cultural Heritage Map." Internet, 2023. Accessed: 22 May 2025. Site: https://www.arcgis.com.
2.ArtGlass Group. "Pompeii Archaeological Park – Augmented Reality Experience." Internet, 2023. Accessed: 22 May 2025. Site: https://artglassgroup.com.
3. Boritt, J. The Gettysburg Story. Internet, 2019. Accessed: 25 May 2024. Site: https://gettysburgstory.com.
4.Carrières de Lumières. Internet, 2020. Accessed: 22 May 2025. Site: https://www.carrieres-lumieres.com.
5.Character.AI Group. "AI-Powered Character Interaction Platform." Internet, 2024. Accessed: 22 May 2025. Site: https://beta.character.ai.
6.Flash Point History. "The Battle of Tours 732: A Turning Point in History (Video)." Internet, 2022. Accessed: 22 May 2025. Site: https://www.youtube.com.
7. Mission US Group. "Interactive History Games." Internet, 2024. Accessed: 23 May 2025. Site: https://www.mission-us.org.
8. Miskimon, C. "Slaughter at the Battle of Cannae." Warfare History Network. Inter-net, 2025. Accessed: 2 June 2025. Site: https://warfarehistorynetwork.com.
9. Pivada Group. "Real Appearances of Roman Emperors with Face Reconstruc-tions." Internet, 2024. Accessed: 27 May 2025. Site: https://www.pivada.com.
10.The Ancient Connection. "Megaliths of Guatemala." Internet, 2024. Accessed: 28 May 2025. Site: https://www.theancientconnection.com.
11. Waterloo Memories. "Waterloo 1815: The Battle That Changed Europe." Internet, 2018. Accessed: 20 May 2025. Site: https://www.youtube.com.
12. Yevgeni Khaldei. "Raising a Flag Over the Reichstag." Internet, 2022. Accessed: 20 May 2024. Site: https://warfarehistorynetwork.com.
Military History in the Age of Artificial Intelligence: A Digital Revolution Rewriting the Past
Colonel Ziad Jalbout
Artificial intelligence has profoundly transformed the way we study military history. Thanks to this technological advancement, it is now possible to examine a large quantity of historical documents with supreme speed and accuracy. This progress has not only improved the quality of data but also paved the way for discoveries that were previously out of reach using conventional methods. For example, LIDAR techniques can now be used to explore archaeological sites and buried military installations that had eluded previous archaeological discoveries. On an individual level, it is now also possible to examine the life of a combatant over the centuries from a biological and psychological perspective, as well as to analyze the impact of environmental and meteorological elements that surrounded him during battle.
Artificial intelligence has also enabled the renewal of military history education. The student is no longer merely a passive recipient of knowledge but becomes an active participant in a virtual environment that simulates combat. For example, virtual and augmented reality technologies allow for the recreation of past battle scenes. This virtually immerses the student in the heart of historical events. Conversations with historical figures created by artificial intelligence also offer a better understanding of historical events. Moreover, adaptive learning offers tailored training programs. These methods promote learner autonomy while adapting to their abilities.
However, real challenges have emerged regarding the reliability of artificial intelligence in the field of military history. Indeed, despite their outstanding ability to process data, they still fail to fully grasp the complexity of cultures and civilizations. This may lead to results that are not always reliable. Furthermore, by relying on data that may sometimes be incomplete or biased, algorithms are likely to produce incomplete narratives. It is also essential to emphasize that artificial intelligence, without the oversight of a knowledgeable human, cannot distinguish between facts and bias on its own. Based on this observation, the study concludes that the future of military history does not lie in replacing humans with machines, but rather in establishing a complementary relationship between artificial intelligence and the critical historical method.
L’histoire militaire à l’ère de l’intelligence artificielle : une révolution numérique qui réécrit le passé
Colonel Ziad Jalbout
L’intelligence artificielle a profondément modifié la façon dont nous étudions l’histoire militaire. C’est grâce à cette avancée technologique qu’il est désormais possible d’examiner une grande quantité de documents historiques avec une rapidité et une exactitude inégalées. Cette avancée a non seulement amélioré la qualité des données, mais elle a aussi ouvert la voie à des découvertes qui étaient auparavant hors de portée avec les méthodes conventionnelles. Par exemple, on peut maintenant utiliser des techniques de LIDAR pour explorer des sites archéologiques et des installations militaires enfouies qui avaient échappé aux découvertes archéologiques précédentes. Au niveau individuel, on peut désormais également examiner la vie d’un combattant au fil des siècles du point de vue biologique et psychologique, ainsi que scruter l’impact des éléments environnementaux et météorologiques qui l’entourait dans la bataille.
L’intelligence artificielle a permis de renouveler l’enseignement de l’histoire militaire. L’étudiant ne se contente plus dorénavant d’accumuler passivement les savoirs, mais il devient un participant actif dans un environnement virtuel qui simule les combats. Par exemple, les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée permettent de recréer les scènes de bataille du passé. Cela plonge virtuellement l’étudiant au cœur des événements historiques. Les conversations avec des personnages historiques, créées par l’intelligence artificielle, offrent aussi une meilleure compréhension des événements historiques. En outre, l’enseignement adaptatif propose des programmes de formation sur mesure. Ces méthodes favorisent l’autonomie de l’apprenant tout en s’adaptant à ses aptitudes.
D’autre part, de véritables défis sont apparus concernant la fiabilité de l’intelligence artificielle dans le champ de l’histoire militaire. En effet, malgré les compétences remarquables des algorithmes en termes de calcul, ils n’arrivent toujours pas à comprendre pleinement la complexité des cultures et des civilisations. Cela risque de donner des résultats non toujours fiables. De plus, en se basant sur des données qui peuvent parfois être incomplètes ou altérées, les algorithmes sont susceptibles de produire des histoires incomplètes. Il est également essentiel de souligner que l’intelligence artificielle, sans la surveillance d’un être humain informé, ne peut pas faire la différence entre faits et préjugés de manière autonome. Sur la base de cette observation, l’étude conclut que le futur de l’histoire militaire ne dépend pas du remplacement de l’homme par la machine, mais plutôt de l’établissement d’une relation complémentaire entre l’intelligence artificielle et la méthode historique critique.