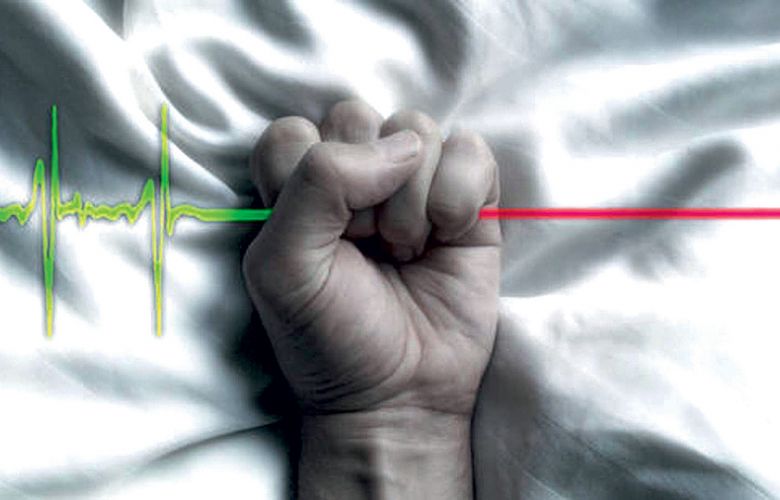- En
- Fr
- عربي
قصة قصيرة
حدّثني صاحبي، قائلًا: الشهر الفائت قصدتُ أخي المقيمَ في بلاد العمّ سام للاطمئنان عليه والاستجمام؛ فأمضيتُ برفقته يومين ممتعين. وفي صبيحة الثالث قال لي: اليوم سأصحبك في رحلة مثيرة مختلفة عمّا قمنا به حتى الآن من رحلات.
جلستُ إلى جانبه في سيّارة طويلة كان قد ركّب فيها تجهيزات خاصّة جعلتْها مؤهّلة لنقل المُقعَدين من الناس إلى الملاعب الرياضية، والحدائق العامّة، والمكتبات الكبيرة، ودور العبادة، وصالات السينما، وعيادات الأطبّاء، ومن ثم إعادتهم إلى بيوتهم.
توقّفنا في فِناء بيت جميل من طبقتين تحيط به حديقة غنّاء؛ فترجّل أخي، وضغط زرّ الجرس الكهربائيّ عند بوّابة الحديد العالية، وأعلمَ أصحاب الدار بوصولنا. وبعد أقلّ من عشر دقائق، فُتح الباب ليظهر فيه عجوز نيّف على السبعين من العمر، جالسًا على عربة مدولبة تدفعها زوجته على مهل، كأنّها تريد أن تتقدّم ولا تريد.
كان العجوز يرتدي بزّة أنيقة، ويعقد ربطة عنق حمراء، وينتعل حذاء جديدًا، وأمارات الرضا والطمأنينة بادية على وجهه. ولكن ما أدهشني وحيّرني هو رؤية زوجته تبكي بصمت، وترتدي ثيابًا سودًا بلون روحها الحزينة.
مددتُ يديّ أساعد أخي في رفع العجوز على عربته إلى السيّارة. وبعدما صعدت زوجته وجلست إلى جانبه واحتجزت كفّيه الهزيلتين بيديها المعروقتين، انطلقنا على مهل، وكان السكوت رفيقنا طوال الطريق. لقد كان العجوز ساكتًا لأن فكره كان مشغولًا في ما سيجيب به عن أسئلة ربّه عندما يلقى وجهه. والزوجة ساكتة لأن دموعها هي التي كانت تتكلّم عنها. وأخي لم يجد ما يقوله في حضرة الموت الجليل. وأنا فعلت فعلهم لأني لم أكن عارفًا إلى أين نحن ذاهبون.
وتابع صديقي حكايته، قال: توقّفنا عند مدخل المستشفى، وأنزلنا الرجل؛ فحضر مَن ساعد الزوجة في دفع العربة إلى الداخل.
- سأكون منتظرًا في موقف السيّارات، قال أخي.
- حسناً يا ابني. ليُجازِك الله خيرًا، ردّت العجوز.
وفيما نحن منتظران في المرأب، سألت أخي: ما الحكاية؟ أجاب: هذا المسكين يعاني، منذ زمن، صداعًا شديدًا لا يتركه يرتاح. إنه من النوع الذي لا يُحتمَل، بحيث أن الرجُل كثيراً ما كان يضرب الحائط برأسه حتى تسيل منه الدماء. العقاقير عجزت، والأطبّاء استسلموا. لذلك راح العجوز يتمنّى الموت. ولمّا كان الموت لا يأتي، قرّر أن يذهب بنفسه إليه.
- آه!! لقد جاء يقتل نفسه إذًا.
- قانون هذه الولاية يسمح بالموت الرحيم. هل سمعتَ بهذا المصطلح من قبل؟
- أنا أسمّيه قتلًا وانتحارًا لا موتًا رحيمًا. وأضفتُ بين الجدّ والمزاح: إذا كان الصداع، في بلداننا، حجّة لطلب الموت، فنصف الناس ينتحرون. ولمّا لم يعلّق أخي على كلامي، تابعتُ أقول: ما دام الرجُل يطلب الموت، فلمَ لا ينتحر في بيته؟! أمِنَ الضروريّ أن يحمّل الطبيبَ جريمة قتله؟!
- قد لا يكون باستطاعة المُقعد تدبُّر وسيلة يُنهي حياته بها. والمرء قد يَجْبُن عن مدّ يده بقتل نفسه في اللحظة الفاصلة بين النيّة والفعل. أضِفْ إلى ذلك أن الموت في المستشفى أيسر، على أهل الميت، منه في البيت.
- أهكذا، وبكلّ بساطة، يقتل الطبيب كلّ مَن رغب في الموت بحجّة أنه رحيم؟!
- لا يا أخي. القانون الذي سنّته الولاية بعد طويل درس وأخذ وردّ، يشترط شروطًا كثيرة، ليس أقلّها أن تؤلَّف لجنة أطبّاء يُقِرّون بالإجماع أن حالة المريض لا شفاء منها، وأن ألمه من النوع الذي لا صبر للإنسان عليه.
- مهما كان، فإنه ليس من حقّ الإنسان قتل روح وهبها الله. للخالق وحده حقّ استرجاع أمانته، من مخلوقه، إذا أراد.
وأضاف صديقي يقول: في هذه الأثناء خرجت العجوز باكية تجرّ قدميها؛ فأسرعت وأخي إلى الإمساك بيديها، ومساعدتها على ركوب السيّارة. ثم عدنا بها إلى البيت حيث استمهلتْنا لبعض الوقت، فدخلت ثم خرجت، ودفعت إلى أخي بمغلّف فتحه ونظر ما فيه: «هذا كثير يا «أمّي». ما قمتُ به لا يستأهل هذا المبلغ الكبير». فقالت: هذه رغبة المرحوم لأنك كنت لطيفًا ومحبًّا. لا أراك الله مكروهاً يا ولدي.
* * *
حكاية صديقي هذه بقيت تدور في بالي زمناً. وكلّما فكّرتُ فيها، ازددتُ رفضاً للموت الرحيم واعتراضًا عليه إلى أن حدثَ ما قلبَ قناعتي رأسًا على عقب.
ما حدث هو أني زرتُ يومًا قريبًا لي بعد انقطاع عنه لزمن؛ فوجدته في البيت وحده، ويتهيّأ للخروج. وكان على عجَلة من أمره.
- لَكَمْ وَدِدْتُ أن تكون زيارتك في غير هذا الوقت، فأتمكّن من الجلوس معك، ومحادثتك، والاستماع إلى أخبارك! لكن... عليّ الخروج في الحال، ولست أعرف كيف أعتذر منك.
- لا داعي للاعتذار. أنا سأغادر أيضًا، قلت ووقفت. كان حريًّا بي الاتّصال بك قبل أن أجيء.
- لا تُسِئْ فهمي أرجوك، قال وأمسك بمعصمي، وطأطأ رأسه معتصمًا بصمت حزين.
- ما الأمر؟! لقد شغلتَ بالي حقًّا.
- إنها أمّي.
- ما بها؟ هل هي مريضة؟
- إنها تموت.
- ماذا!!!
- هي الحقيقة. لقد ضربها المرض الخبيث في عظامها. ويا ليتها لا تتألّم. لكنها تتعذّب، وصراخها لا ينفكّ يدور في رأسي ويدوّي في أذنيّ.
- يا لَهذا النبأ ما أشدّ وقْعه!!
- لا أعرف، والله، ما عليّ أن أفعل. صدّقني إن قلت لك إنّ عقلي قد تعطّل. يا ليتني أستطيع أن أحمل بعض الألم عنها فأرتاح، قال ولمعت دمعتان في عينيه.
- أين هي؟
- في المستشفى.
- هيّا إذًا. سأرافقك إلى هناك.
قدتُ سيّارتي خلف سيّارته. ولما بلغْنا المستشفى وعبرْنا المدخل، كان الصراخ الآتي من آخِر الرُواق، يفتّت القلب، بل حجر الصوّان.
دخلنا الغرفة؛ فرأيت المرأة تتلوّى في السرير تألُّمًا على الرغم من المخدّر الذي ينساب مع المصل إلى شرايينها. وكان زوجها وابنتها وطبيبها وإحدى الممرّضات عن جانبي سريرها.
وضعتُ يدي على يدها؛ فنظرتْ إليّ، وسالت دمعتان على خدّيها المصفرَّين، ثم أغمضت عينيها، وعادت تئنّ حينًا وتصرخ أحيانًا. وبعدما طمأنها الطبيب إلى أن الألم سيخفّ بعد قليل بفعل المخدّر، خرج؛ فلحقتُ به واستوقفته: «حضرة الدكتور، أنا قريبها. ولها من المحبّة في قلبي ما لأمّي. ألا تستطيعون إيقاف ألمها بطريقة أو بأخرى؟».
- ليس من الحكمة أن نعطيها اليوم الحدّ الأقصى من الجرعة التي سرعان ما يعتادها جسمها، فلا يستجيب بعد ذلك لها. مرضها سيتفاقم، وألمها سيشتدّ. وكلّما زاد الألم شدّة، زدنا الجرعة قليلًا. لكن ثمّة حدّ إذا تخطّيناه، ماتت.
- ألا تستطيعون أن تجعلوها تنام؟
- الألم الشديد يحول دون نوم المريض إلا إذا كان المخدّر قويًا جدًّا. والجرعة الزائدة تقتل كما أسلفتُ القول.
تركتُ الطبيب يذهب إلى حقل آخر، في المستشفى، من حقول المعركة بين الحياة والموت. وعدتُ إلى الغرفة؛ فرأيت المرأة ترجو الممرّضة أن تريحها من عذابها. أن تزيد لها جرعة المورفين. ولما لم تلتفت الممرّضة إليها أو تقُل كلمة، واكتفت بضبط إيقاع سيلان المصل في الأنبوب، راحت المسكينة تنظر في عيوننا، وتتوسّلنا واحدًا واحدًا ألا نُطيل عذابها بعد، طالبةً الموت الرحيم.
عدتُ إلى بيتي وعبارة «الموت الرحيم» تتردّد في خاطري وقد سرقت راحتي وسكينتي. فكرّتُ فيها طويلًا، وسألتُ نفسي مراراً: «أيكون قتل النفس، تخليصاً لها من العذاب، جريمة، وتركها في عذابها، لا يكون؟ أليس الإنسان مسؤولاً عمّا يفعله، وفي أحيان كثيرة، عمّا لم يفعله أيضًا!». فأجابت نفسي: «حسنٌ أنك قلتَ «في أحيان كثيرة»، لأنْ ثمّة أحيان يكون فيها الامتناع عن الفعل بطولة وفضيلة».
لم يقنعني جواب نفسي. فحملتُ تساؤلي ودرتُ بين الناس فيه؛ فسألتُ راهبًا يفترش في صومعته الأرضَ العارية، ويتوسّدُ عودًا يابسًا، قال: إن كان الألم للجسد عذابًا، فإنّ فيه للروح تطهيرًا. وأضاف: درب القداسة تمرّ دائماً في معارِج الألم والمعاناة.
- ليس كلّ مَن تعذّب، يا أبتِ، صار قدّيسًا. لكن كلّ مَن خلّص الناس من عذابهم، قد صار.
- وصيّة ربّنا واضحة: لا تقتلْ. وليس لنا أن نجتهد في تفسير وصايا الربّ.
تأبّطتُ حيرتي مجدّدًا، وعدتُ أبحث عمّن يريحني منها أو يساعدني في حملها؛ فسألتُ شيخًا متجلببًا بالورع والفضيلة، قال: على الحياة أن تجاهد وتجالد كلّما بقي فيها رمق يستطيع أن يقاوم. وأضاف: القتل محرَّم، وهَتْك المحرَّمات جريمة. قلت: أيها الشيخ الجليل. كم قاتلٍ بالسيف، مقتول؛ وقاتلٍ بالكلمة، محمود ومشكور!
بعد أيّام عدتُ قريبتي في المستشفى مرّة ثانية. لكن، هذه المرّة، كان صراخها أعلى، ولون بشرتها يحاكي الزعفران اصفراراً. لقد كان الموت متأهّبًا عند سريرها بعدما كان بالأمس منتظرًا خارج بابها.
رأيتها تمسك ملاءة السرير بيديها، بل تغرز فيها أصابعها وأظافرها وتشدّ بكلّ قوّتها، وترنّح رأسها يمنةً ويسرةً، وتعضّ شفتها السفلى مغمضة العينين، فيما العرق يغسل وجهها الترابيّ الذابل. لقد أصبح ألمها أقوى من أن يُحتمل.
«ارحموني. اقتلوني. خلّصوني من عذابي. حرام عليكم تركي أتوجّع... يا ربّ. يا ألله. يا محبًّا للبشر، لماذا لا تريحني؟!». هكذا كانت المسكينة تصرخ، فيما كانت ابنتها تبكي بصوت عالٍ، وزوجها في مقعده طامراً رأسه بين يديه، وابنها يرجو الطبيب أن يجعلها ترتاح.
- ماذا تريدني أن أفعل؟! أأقتلها! لا أستطيع أن أزيد جرعة المورفين بعد.
- لا أعرف يا دكتور، لا أعرف. إفعل لها شيئاً أرجوك. هذه أمّي. أمّي التي ولدتني وربّتني بتعب يديها وسهر عينيها. هكذا كان ابنها يقول ويبكي؛ فبكيت، والله، لبكائه. حتى الممرّضة هذه المرّة بكت.
خرج الطبيب والممرّضة؛ فخرجتُ وقريبي في إثْرهما.
- يا دكتور، هل من أمل في شفائها؟ سألتُ.
- لا، إلا إذا تدخّل القدّيسون بأعجوبة.
- وهل سيطول عذابها؟
- الأعمار في يد الله. لكن أعتقد أنّها ستصمد مدّة شهر على الأقلّ.
- ماذا!! صرخ قريبي. عذاب لأكثر من شهر بعد!! لا يا دكتور. لا أستطيع أن أتحمّل رؤيتها تتعذّب كلّ هذه المدّة. لا أستطيع، لا أستطيع. قال وراح ينتحب.
صرف الطبيب الممرّضة وقد اتّشح بياض عينيه ببعض احمرار تأثُّراً وإشفاقاً. وبعد طويل تردّد، أشار بأن نتبعه إلى عيادته، فتبعناه. أغلق الباب، وجلس على الكرسيّ خلف طاولته، وقال وهو يرفع بعض الأوراق أمامه ويضعها في مكان آخر من غير سبب: «حاجتك في هذه الخزانة». وإذ سارع قريبي إلى فتحها، وجد بضع إبر تناول أكثرها امتلاءً، وسأل: «أهي كافية؟»؛ فرفع الطبيب بصره للحظة، وهزّ رأسه أنْ نعم، وعاد ينظر إلى الأوراق بين يديه.
- أأُفرغ محتواها في كيس المصل؟
- عملي هذا قد يودي بي إلى محاكمتين: واحدة في الأرض، وأخرى في السماء.
- لا تقلق يا دكتور. سأكون حذرًا جدًّا.
- إن لم يعلم البشر، أفلا يعلم الله!
- سيجازيك خيرًا إذ رحمتَ إنسانًا يتعذّب.
أخفى قريبي الحقنة في جيبه وخرج؛ فخرجتُ خلفه. ولما دخلنا غرفة أمّه، ارتمى على السرير عند قدميها، وأخرج الحقنة من جيبه، وقال ودموعه تنهمر كالمطر على خدّيه: أتسامحينني يا أمّي؟ فهزّت رأسها بالإيجاب، وهي تتلوّى من الألم.
- ستزول أوجاعك بعد قليل إلى الأبد يا أمّي.
- ليرضَ الله عنك يا ولدي.
نظر قريبي إلى أبيه؛ فأشار عليه بالموافقة. إذ ذاك وقف، وحقن كيس المصل بالمخدّر القويّ، وأودع الحقنة الفارغة جيبه. ثم جلس وأخذ يد أمّه بين يديه، ورفعها إلى صدره، ثم إلى شفتيه. أما أخته فوضعت يديها المرتجفتين على شفتيها، وفتحت عينيها واسعتين تفجّعاً. ولما خانتها قواها، هبطت على ركبتيها إزاء السرير تنتحب. وأما الزوج فنهض من مقعده، ووقف عند رأس زوجته يسرّح شعرها على مهل بأصابع ترتعش.
شيئًا فشيئًا أخذ الألم يخفّ، ثم توقّف؛ ففتحت الأمّ عينيها. ووضعت يمناها على رأس ابنتها التي ما زالت جاثية بقربها. وأخذت بيسراها يد ابنها. ثم أوصتهم جميعًا بأن يبقوا متحابّين متضامنين. ودعت لهم بأعمار مديدة لا كدر فيها. وفيما كانوا جميعًا يبكون بصمت، لوت رأسها، ولفظت روحها وهي تبتسم.