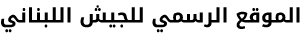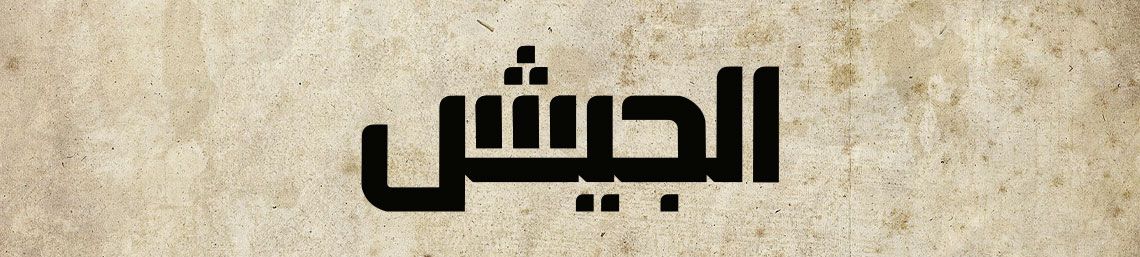- En
- Fr
- عربي
تاريخ حديث
عُرضت في العام 1973 مسرحية ”المحطة“ للأخوين عاصي ومنصور الرحباني على مسرح قصر البيكاديلي ببيروت، فاشتهرت أغانيها، ومن بينها أغنية ”يا رئيس البلدية“ لفيروز ونصري شمس الدين، التي تصف الواقع البلدي الحزين بفكاهةٍ. فبينما تُعلّق الآمال على رئيس البلدية في ما خصّ أمورًا كثيرة، يبدو الأخير عاجزًا عن إيجاد الحلول إلى درجة تجعله يستعين بملوك الجان لحل المسائل المعقدة…
اليوم، تؤدي بعض البلديات دورًا مهمًا في نهضة مناطقها، وترزح بلديات مناطق أخرى تحت وطأة عجز متعدد الأسباب، ويبدو أهلها وكأنهم ما زالوا في زمن ”المحطة“، وانتظار قطار التنمية.
نشأت البلدية في لبنان خلال القرن التاسع عشر، وكانت يوم ذاك عبارة عن هيئة أهلية محلية يتم تعيينها من قبل السلطات. وقد ظهرت بادئ الأمر في عهد السلطان العثماني عبد العزيز (1861-1876) بعد أن جرى اقتباسها عن النموذج الأوروبي. ومنذ العام 1867، بادر الولاة العثمانيّون إلى إنشاء مجالس بلدية اعتمدت التنظيمات المطبّقة في العاصمة العثمانية وذلك بعد إنشاء بلدية اسطنبول وإصدار الأنظمة الخاصة بها سنة 1857.
تطوّرت هذه المجالس مع «نظام إدارة الولايات العمومية» سنة 1871 الذي خصّ تنظيم المجالس البلدية بفصلٍ كامل، ونصّ على إنشاء البلديات في مراكز الولايات والألوية والأقضية، وبناءً عليه تأسست البلديات في هذه المراكز، وعرفت نموًّا بعد صدور قوانين المجالس البلدية سنة 1877 التي جعلت البلدية وحدة إدارية مستقلّة بنظامها وميزانيّتها وصلاحياتها. وقد أتت مجمل التنظيمات البلدية نتيجة السياسة الإصلاحية التي انتهجتها السلطنة العثمانية منذ العام 1839 تجاوبًا مع إرادة التطوير والإصلاح والتحديث. ضمن هذا الإطار التاريخي العام، نشأت البلديات في متصرفية جبل لبنان وتطوّرت حتى أحدثت تغييرات جذرية في العديد من القرى والبلدات التي قامت فيها. وفي الوقت نفسه ظهرت بلديات المدن والمناطق اللبنانية التي اقتطعها النظام الأساسي عن جبل لبنان، لكن التنظيمات والقوانين تباينت بينهما، فخضعت بلديات الجبل للمجلس الإداري اللبناني، وارتبطت بلديات المدن اللبنانية الأخرى بوزارة الداخلية العثمانية.
سنتناول في دراستنا تاريخ البلديات في متصرفية جبل لبنان (1861-1918) وفي المناطق اللبنانية الأخرى التي كانت تابعة للولايات العثمانية، وكيف تطوّرت تلك البلديات وقوانينها خلال عهد الانتداب الفرنسي (1920-1943)، ومن ثم بين العامين 1943 و1990 بخاصةٍ خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب، لنستعرض من ثمّ عدد البلديات وتطوّرها منذ العام 1998 وحتى اليوم.
البلديات الأولى في متصرفية جبل لبنان (1864 – 1900)
نشأ نظام متصرفية جبل لبنان باتفاقٍ دولي وإقرار عثماني في
9 حزيران 1861، وبعد إدخال بعض التعديلات عليه صدر النظام الأساسي في حلّته النهائية في 6 أيلول 1864. فصل هذا النظام جبل لبنان (3727 كلم2) عن بيروت وصيدا وصور ومرجعيون وطرابلس وعكار والبقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا التي تبعت نظام الولايات العثمانية واعتمدت قوانين الدولة العليّة. وانقسم جبل لبنان تبعًا لهذه الصيغة الجديدة إلى سبعة أقضية هي: الكورة، البترون، كسروان، المتن، الشوف، جزين، وزحلة، ومديرية دير القمر. استمر تطبيق النظام الجديد حتى العام 1915، تاريخ السيطرة العثمانية المباشرة على جبل لبنان غداة الحرب العالمية الأولى.
ولما كان لبنان منقسمًا بين متصرفية جبل لبنان والمقاطعات اللبنانية، التي تغيّرت تبعيّتها لأكثر من ولاية (دمشق وعكا وطرابلس وصيدا وبيروت)، فإنّ الوضع الإداري فيهما كان متباينًا بخاصةٍ وأنّ بروتوكول 1861 وتعديلاته لم يلحظ أي ذكر للبلديات، خوفًا على ما يبدو من أن يؤدّي استقلالها إلى إضعاف سلطة المتصرّف. لكنّ المتصرّف الأول داود باشا اتّخذ سلسلة إجراءات إدارية وتنظيمية لردم الهوّة التي خلّفتها أحداث 1860. ولما رأى ما حلّ من خراب ودمار بدير القمر «عاصمة الجبل» آنذاك، خصّها في سنة 1864 من دون سواها «بقومسيون Commission» بلدي للاهتمام بها والسهر على نظافتها وترتيبها، فكان أول قومسيون من نوعه في جبل لبنان، مكوّنًا من 7 أشخاص معتبرين في البلدة. وكان للمجلس كاتب، يجتمع كل يوم جمعة برئاسة مأمور دير القمر، ويستثمر بعض الأموال ويوظّفها بالفائدة من أجل تغطية المصاريف. هذا في المتصرفية، أمّا في المقاطعات اللبنانية الأخرى فقد تأخّر إنشاء البلديات إلى حين صدور القانون التنظيمي في العام 1867 الذي نظّم إنشاء البلديات في السلطنة العثمانية، وفي العام نفسه تأسّست بلدية بيروت. وقد تلازم ظهور البلديات مع ظهور مشايخ الصلح (المخاتير زعماء القرى المنتخبين).
من الحسبة إلى البلدية: أوجدت حكومة المتصرفية «مصلحة الحسبة» أي الموارد المالية، وعملت على استيفاء رسومها من البلدات التالية: زحلة، جونيه، طبرجا، جبيل والبترون. وكانت غالبية هذه الرسوم تدخل في صندوق المتصرفية، في حين يُصرف القسم الآخر لإصلاح البلدات المذكورة. غير أنّ نجاح التجربة البلدية في دير القمر شجّع حكومة المتصرفية على إلغاء نظام الحسبة، والعمل على إحلال المجالس البلدية محلّها. فعندما تسلّم رستم باشا (1873-1883) سدّة الحكم في جبل لبنان، طالبه الأهالي بتكرار تجربة دير القمر الرائدة. ولمّا كان رستم يهوى الأناقة والنظافة والجمال، وينفر من منظر الأوساخ في الطرق المعوجّة والأزقة القذرة، تجاوب مع مطلب الأهالي وشجّع على إنشاء المجالس البلدية، فاستصدر من مجلس الإدارة في 24 كانون الأول 1878 قرارًا ينص على تشكيل مجالس بلدية من الأشخاص المشهورين بالاستقامة، وحب الاهتمام بالخير العام، ومبتعدين عن المصالح الشخصية، وذلك في كل من زحلة وجونيه وجبيل والبترون وطبرجا والعقيبه. وقد أصدر المجلس الإداري مبادئ تنظيم عمل البلديات المستحدثة التي نصّت على ترؤُّس مدير الناحية القومسيون البلدي، والدعوة إلى الاجتماعات لتنفيذ الإصلاحات، على أن يرفع بيانًا تفصيليًا في نهاية كل عام يتضمّن أعمال المجلس وحساباته، باستثناء المشاريع التي يمنح رخصها المتصرف.
أول محاولة تشريعية تنظيمية للبلديات: مع اتّساع نطاق العمل البلدي، لم تعد هذه المبادئ تفي بالحاجة، فاشترع المجلس الإداري سنة 1879 قانونًا خاصًا من 14 مادة، وكان أوّل محاولة تشريعية تنظيمية للبلديات في جبل لبنان، وقد حدّد صلاحيات البلديات وواجباتها، وشكّل حافزًا نوعيًا للعمل المناطقي.
أصدر رستم باشا قرارات جديدة سنة 1880 نصّت على تأسيس بلديات في بشري وبسكنتا ودوما. ومع هذه الخطوات المتقدّمة أخذ المتصرّفون المتعاقبون على حاكمية جبل لبنان يولّفون القومسيونات البلدية في القرى الأساسية، فبلغ عددها 36 بلدية سنة 1900. لم تطبّق متصرفية جبل لبنان القوانين البلدية العثمانية، وإنما لجأت إلى استصدار قواعد خاصة بها، أسمتها «تعليمات» وليس «قوانين»، حتى لا تُثير مخاوف السلطات العثمانية وشكوكها. بدأت البلديات تعيش مرحلة الاستقلال الذاتي مع بداية السماح لها بانتخاب الرئيس من بين أعضاء القومسيون. بيد أنّ هذا التصرف لم يشمل البلديات كافة بخاصةٍ ما بين 1864 و1902 إذ ظل منصب الرئيس خاضعًا للتعيين في هذه المرحلة. ويُظهر الجدول رقم 1 البلديات التي تأسست بين العامين 1864 و1900.
عهد مظفّر باشا (1902-1907): تطوّر البلديات
وصل مظفّر باشا إلى بيروت في 14 تشرين الأول 1902، وإثر انتقاله إلى بعبدا طرح برنامجًا إصلاحيًا مهمًّا طال جوانب الإدارة كلّها. فأعاد النظر في الحدود الجغرافية للمتصرفية، وفي الأوضاع الحكومية وأحوال الجندرمة والقضاء. واعتمد طريقة جديدة لانتخابات مشايخ الصلح وأعضاء المجلس الإداري، وتمّ استحداث 29 بلدية سنة 1906، ليبلغ مجموع البلديات 65 ممثِّلة لـ 77 قرية وبلدة. ترافق ذلك مع إصدار المتصرف مظفر باشا تعليمات بلدية جديدة إضافة إلى تلك التي كان معمولًا بها، فبلغ عددها 30 مادة أقرّها مجلس الإدارة سنة 1907 للعمل بموجبها. والبلديات التي تأسّست سنة 1906 هي: مجد المعوش، بتاتر، رشميا، شرتون، الشويفات، عبيه، كفرمتى، فالوغا، العبادية، قرنايل، كفرسلوان، بكفيا، (ساقية المسك وبحرصاف)، المحيدثة، قرنة الحمرا، (أنطلياس والنقاش والضبيه وجل الديب)، كفرعقاب، الحدث، بكاسين، قرطبا، كفرحزير، شكا، بشمزّين، أنفه، بطرام، كفرعقا، كفرحاتا، الهرمل، وكفرذبيان.
بين 1908 و1918: بداية الانتخاب
لم يُطبّق قانون البلديات الذي تمّ إعداده في عهد مظفّر باشا، وبقيت طريقة تشكيل المجالس البلدية عرضة للتجاذبات المحليّة الضيّقة والنزاعات السياسية. ومع هذا فقد تطوّر العمل البلدي في عهدي يوسف باشا (1907-1912) وأوهانس باشا (1913-1915). ومع إعادة العمل بالدستور العثماني في 23 تموز 1908، بدأ اللبنانيون في جبل لبنان يطالبون بالحرية، فأصدر المجلس الإداري في 30 أيلول 1908 قرارًا دعا فيه إلى انتخاب أعضاء البلديات بالتصويت العام. وهكذا أضحى المبدأ الانتخابي مظهرًا من المظاهر الجديدة التي غمرت البلاد. أما آلية الاقتراع فكانت تجري على قاعدة حضور الناخب، فإذا كان أميًّا أملى على رئيس القلم أسماء مختاريه، فتُكتب على ورقة وتُلقى في الصندوق. وإذا كان الناخب غير أمّي يعطيه رئيس القلم ورقة يكتب عليها الأسماء ويرميها بالصندوق.
اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى سنة 1914، فاستغلّت السلطنة العثمانية الظروف المستجدة لاحتلال جبل لبنان بقيادة وزير البحرية جمال باشا الذي قدم إلى دمشق مستدعيًا أوهانس باشا لمقابلته، فاستقال هذا الأخير وغادر لبنان، وربط جمال باشا متصرفية جبل لبنان بوزارة الداخلية العثمانية، وعمل على تعيين علي منيف بك متصرفًا على «لواء جبل لبنان». وبهذا التعيين الذي انفردت به الدولة العليّة انتهت امتيازات الجبل التي دامت أربعًا وخمسين سنة. فهمّش الحكم الجديد دور المجلس الإداري، وأبقى البلديات قائمة تعمل في ظل الحكم العثماني المباشر. فتمّ عزل الأمّيين، وعاد العمل بمبدأ تعيين رؤساء البلديات، وتخصيص معاش شهري للرئيس، وتكثيف الاجتماعات، كما تمّ إقرار مبدأ «تعميم البلديات» الذي اتّخذه مجلس الإدارة في 17 آذار 1916، ومآله تعميم البلديات في قائمقاميات الجبل، لكن هذا القرار كان صعب التحقيق بخاصةٍ في ظل المجاعة التي أصابت جبل لبنان. وطالب العثمانيون بانتخاب ممثلين عن جبل لبنان في «مجلس المبعوثان»، وانتخاب أعضاء المجلس العمومي في «لواء لبنان»، وكلّفوا مفتّشين على البلديات، وطبّقوا القانون البلدي العثماني بخاصةٍ على البلديات التي حلّ موعد تجديدها. وقد بلغ عدد البلديات المستحدثة في السنوات العشرة الأخيرة من العهد العثماني 19 بلدية كما يظهر في الجدول رقم 2.
البلديات في المدن والبلدات اللبنانية التي كانت تابعة للولايات العثمانية
انتهى العهد العثماني في لبنان سنة 1918، ولما رأى والي بيروت اسماعيل حقّي انسحاب الجيش العثماني، استدعى رئيس البلدية عمر الداعوق، وأبلغه تنحّيه عن الحكم وسلّمه أوراق المدينة ومقاليد السلطة فيها. وفي صيدا وصور وطرابلس والنبطية وبعلبك والمناطق كافة، تولّى رؤساء البلديات زمام الحكومة لفترة انتقالية. في بعبدا، سلّم الحاكم العثماني ممتاز بك حكومة الجبل إلى رئيس بلدية بعبدا حبيب فيّاض. وفي جونيه أدار رئيس بلديّتها نجيب أبي زيد الأعمال. وعلى هذا القياس، سارت بعض المؤسسات البلدية التي ملأت الفراغ الذي خلّفه العثمانيون عند نهاية الحرب العالمية الأولى. وكان العثمانيون قد أسّسوا 13 بلدية في مدن وقرى كانت تابعة للولايات العثمانية ضُمّت إلى دولة لبنان الكبير سنة 1920، وهي تظهر في الجدول رقم 3.
الجهاز الإداري البلدي وصلاحياته خلال عهد المتصرفية
بلغ عدد البلديات في متصرفية جبل لبنان خلال العهد العثماني (1864-1918) 84 بلدية. وقد وزّعت التعليمات البلدية المهمات الأساسية بين المجلس البلدي والموظّفين الإداريين. انقسم المجلس البلدي إلى قسمين: السلطة التنفيذية والسلطة التقريرية. تولّى السلطة التنفيذية رئيس البلدية الذي غطّى في كثير من الأحيان أوجه النشاط البلدي وحجب دور الأعضاء. كما رأس أيضًا السلطة التقريرية، وكوّن مع المجلس وحدة متكاملة تسمّى القومسيون البلدي. لم تحدّد تعليمات 1879 عدد أعضاء هذا القومسيون، بينما جعلت تعليمات مظفر باشا هذا العدد بين 6 و12 عضوًا، وحفظت حق الانتخاب لكل مكلّف في المحل الذي يقيم فيه. ومن شروط العضوية أن يكون الأعضاء من الوجهاء بين الأهالي ومن أصحاب الأملاك في المحل الذي ينتخبون فيه، ومن التبعة العليّة، ومن أصحاب النفوذ والثقافة. بالإضافة إلى ما تقدّم كان المجتمع يراعي بعض القواعد غير المكتوبة التي تبلورت بفعل الممارسة، وأضحت مع الوقت أقوى من النصوص، ومنها مراعاة الطائفية والتمثيل العائلي. وقد حُدِّدت صلاحيات الجهاز الإداري خلال تلك المرحلة على الشكل الآتي:
صلاحيات المجلس البلدي: يقوم المجلس البلدي فور تشكيله باستئجار مركز دائم له، وشراء صندوق حديدي ذي ثلاثة أقفال «ليكون بيد كل من رئيس القومسيون وأمين الصندوق والكاتب مفتاح»، وذلك للمحافظة على أموال البلدية وأوراقها الرسمية. وكان على المجلس أيضًا تجهيز مركزه الجديد بطاولةٍ كبيرة وعدد من الكراسي ودفتر لتسجيل الوارد والخارج ودفاتر إيصالات. وقد حدّدت التعليمات صلاحيات المجالس، وأناطت بها مهمّات إدارية وصحيّة ووقائية وإنمائية وتنفيذية.
سلطة الرقابة: كانت حكومة المتصرفية تقوم بالرقابة الدوريّة على البلديات بواسطة المجلس الإداري اللبناني أو بواسطة القائمقام.
إقالة الأعضاء: كانت عملية فصل الأعضاء وإقالتهم تصدر أحيانًا عن مجلس الإدارة، وأحيانًا أخرى بموجب أمر متصرفي بسبب إقدام العضو على التشويش في أكثر جلسات القومسيون، أو لتخلّفه عن الحضور، أو لتهاونه في تنفيذ التعليمات.
حلّ المجالس البلدية: أقدم مجلس الإدارة على حلّ المجالس البلدية مرارًا، وذلك لأسبابٍ عديدة منها مخالفة التعليمات الصادرة إليه، أو إهمال الواجبات، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو فقدان النصاب القانوني، أو أميّة الأعضاء.
رفض نتيجة الانتخاب أو إقرارها: كان مجلس الإدارة يرفض نتيجة الانتخاب ويلغيها في حال كان الانتخاب غير نظامي، أو حين يتعادل منتخبون لبلدة واحدة في عدد الأصوات، أو حين يكون عدد المنتخبين نصف عدد الأشخاص الموجودين في البلدة. وإذا خلت الدورة الانتخابية من الشوائب والعوائق، صدّق المجلس الإداري عليها وطلب مباشرة الأشغال. وكان المجلس الإداري يحرص على مراعاة التوزيع الطائفي والعائلي والتطور الديموغرافي. لكن الإجراءات التي اتخذت بهدف التطوير والتحديث لم تحل دون استمرار هيمنة المجلس الإداري على البلديات، واستمرار التعيين الاستنسابي عند الضرورة.
دمج البلديات: كان للمجلس الإداري أن يرتَئِي الجمع أو الفصل بين القرى، وذلك وفق التوازن المادي بين الإيرادات والنفقات. وفي هذا السياق تمّ سنة 1879 ضم عمشيت وجبيل في بلدية واحدة، لكن سنة 1890 تمّ فصل البلدتين، وجرى تخصيص كل منهما بقومسيون مستقل عن الآخر.
الموظفون: اعتُبر الموظفون العنصر الأساسي في الأعمال التنظيمية والتنفيذية والإدارية والمالية، لكنهم لم يتحلّوا بقدر وافٍ من الكفاية والمعرفة، ولم يحسنوا تدبير شؤون الناس. وكانت البلديات تفتقر إلى أجهزة فنيّة فاعلة، الأمر الذي أرخى بثقله المادي على موازناتها وحمّلها عبئًا ماليًا أعاق سير العمل وكبّله. فاضطرّت معظم البلديات إلى حصر الوظائف بأعضاء المجلس البلدي. أما أهم الوظائف، فكانت: أمين الصندوق، وكاتب القومسيون، والطبيب، ومفتش البلدية، والدلّال، والبوليس، والحرّاس، ومأمور الأشغال والناطور، وعمّال التنظيفات.
بلديات لبنان الكبير خلال عهد الانتداب الفرنسي (1920-1943)
أراد الفرنسيون تأسيس إدارات في لبنان تشبه النموذج السائد في الغرب، فأوكلوا إلى دائرة التفتيش الإداري مراقبة البلديات، والتدقيق في موازناتها، والعمل على تحسينها ومساعدتها في إنشاء الحدائق والأسواق. وقد بدأت مسألة تطييف البلديات تتضح في العام 1928 مع القرار 1208، الذي نصّ في المادة 19 منه على أنّ عدد ممثّلي كل طائفة يرتبط بنسبة عدد ناخبيها من مجموع المسجّلين في منطقة معيّنة. غير أنّ سلطات الانتداب حاولت منع هيمنة عائلة بكاملها على السلطة البلدية، لكنها ساهمت في المقابل في تعزيز المواقع الاقتصادية والاجتماعية لعناصر عائلية نافذة، ما وفّر لهذه العناصر ارتقاءً سلطويًا، هو في الواقع ارتقاء اجتماعي– سياسي للعائلة كلها. وفي الانتخابات البلدية التي أجريت في العام 1934، حاز معظم مقاعدها أفراد من عائلات معروفة وكان التنافس شديدًا بينها، نظرًا لأهمية البلدية بالنسبة إلى المواطنين.
أُجبرت البلديات في عهد الانتداب على إرسال قراراتها إلى القائمقام، فالمحافظ، فالحاكم الإداري، لأنّها ارتبطت بالسلطة المركزية، الأمر الذي جعل دورها ضعيفًا، وصلاحياتها مقتصرة على التقرير بشكلٍ منفرد في المسائل الإدارية، وشراء العقارات التي لا تزيد قيمتها عن عُشر الدخل البلدي، والقيام بإصلاحاتٍ ومشاريع صغيرة. في المقابل كان يحق للمحافظ أن يلغي القرارات المتخذة خلال 15 يومًا من دون الرجوع إلى البلدية.
تأسست خلال عهد الانتداب الفرنسي (1920-1943) 58 بلدية كما يُبيّن الجدول رقم 4.
البلديات بين مطلع الاستقلال وبداية تسعينيات القرن العشرين
بعد الاستقلال، نظّمت انتخابات بلدية في العام 1952 وتمّ تعيين ثلاث نساء في المجلس البلدي لبيروت. وفي العام 1953 حصلت النساء على حقّهن بالتصويت والترشّح للانتخابات. وبتاريخ 29/12/1954 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 11 المتعلّق بالقانون الجديد للبلديات، لكن لم يتم إجراء انتخابات على أساسه إذ صدر في عهد الرئيس فؤاد شهاب قانون جديد للبلديات تحت الرقم 63 سنة 1963. منح هذا القانون صلاحيات أوسع للبلديات ودورًا أكثر فاعليةً فأصبحت تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري. وبات بإمكانها تخطيط البلدة وإنشاء الشوارع والساحات العامة، والاهتمام بالشؤون الصحية والنظافة العامة، والقيام بمشاريع المياه والإنارة، وتنظيم وسائل النقل، وإدارة الأموال البلدية والإشراف عليها، ووضع موازنة سنوية، بالإضافة إلى الحصول على مساعدة في المشاريع التي تتعلّق بالمدارس الرسمية والمهنية، والمستشفيات، والمتاحف والمكتبات، ودور السينما والأسواق العمومية. شكّلت الانتخابات البلدية سنة 1963 ركيزة أساسية وقاعدة شعبية للانخراط في العمل السياسي ومؤسسات الدولة، وباتت تؤكّد على النفوذ الشعبي للزعامات السياسية الساعية للوصول إلى النيابة أو الوزارة، وهذا ما عزّز نفوذ العائلات نفسها، مما أدّى إلى تأسيس عدد كبير من البلديات خلال سنتي 1963 و1964.
في العام 1970، لم يتمّ إجراء الانتخابات البلدية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان، وفي العام 1975 اندلعت الحرب، فتمّ تعليق الانتخابات البلدية لمدّة 35 سنة. ومع الوقت، بدأت البلديات تفقد نصابها بسبب وفاة أعضائها أو غيابهم، فأخذت الحكومة صلاحيات التعيين، وصارت تعيّن لجانًا قائمة بالأعمال البلدية. أما في القرى التي لم تكن فيها بلديات، فكان هناك ما يسمى بمصلحة البلديات والشؤون القروية، وهي كانت معنية بتسيير شؤونها.
خلال فترة الأحداث (في 30/6/1977)، صدر قانون بلدي جديد بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 الذي وسّع صلاحيات البلديات ونصّ على انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء من الشعب. ولم يكن مسموحًا للإدارة المركزية، الممثلة بالقائمقام والمحافظ ووزير الداخلية، التدخل في إدارتها، إنما كانت مهماتها تقتصر على المراقبة. وسمح هذا القانون للبلدية بأن تضع نظامًا لموظفيها وملاكًا لهم، وأن تنشئ الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف. وفي ما يأتي أبرز ما يتعلّق بتنظيم البلدية وصلاحياتها:
السلطات البلدية: يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وأخرى تنفيذية. تتمثل السلطة التقريرية بالمجلس البلدي، ومدة ولايته ست سنوات. يمكن حلّه بمرسوم مُعلَّل من مجلس الوزراء إذا ارتكب مخالفات مهمة أدّت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. ويُعتبر المجلس البلدي منحَلًّا حكمًا إذا فقد نصف أعضائه أو حكم بإبطال انتخابه، ويتولّى القائمقام أو المحافظ، أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد بقرار من وزير الداخلية. أما السلطة التنفيذية فيتولّاها رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولّاها المحافظ. ويحقّ لرئيس البلدية ولنائبه أن يتقاضيا راتبًا ماليًا.
صلاحيات البلدية: تقوم البلدية بوظائف عديدة أهمّها: التمدّن، البناء، الخدمات والصحة العامّة، الأمن، تنظيم الطرقات وتخطيطها وتوسيعها وتنظيفها وتدوير النفايات، إنشاء الحدائق والساحات العامة، وضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام (بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني)، إنشاء الأسواق، والمنتزهات، وأماكن السباق، والملاعب، والحمامات، والمتاحف، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمكتبات، والمساكن الشعبية، والمغاسل، وصيانة الصرف الصحّي. ومن وظائفها أيضًا المساهمة في نفقات المدارس الرسمية والمشاريع ذات المنفعة العامة، وإسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص، وتنظيم النقل، وإسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات، وإعانة ضحايا النكبات ودعم النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية، والتربوية، وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة والمرافق العامة.
الرقابة على البلديات: تخضع البلديات لرقابة مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
مالية البلديات: تتكوّن مالية البلديات من الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلّفين، ومن الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات، ومن المساعدات، والقروض، والغرامات، وحاصلات أملاك البلدية.
الملاحقات التأديبية والجزائية: جميع أعضاء المجلس البلدي يخضعون للعقوبات التأديبية إذا أخلَّوا بالواجبات التي تفرضها عليهم الأنظمة والقوانين. وإذا صدر قرار ظنّي أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو أحد الأعضاء، جاز كفّ يده بقرار من المحافظ. وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، يُعتبر مُقالًا حكمًا وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.
البلديات اليوم: أسئلة كثيرة
انتهت الحرب اللبنانية في العام 1990، وفي العام 1997 أُجريت تعديلات على القانون 118/1977 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 665. هذه التعديلات قال عنها رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني إنها: «حوّلت سلطة الرقابة إلى وصاية، ولم يعد انتخاب رئيس البلدية يتم مباشرة من الهيئات الناخبة، وأجازوا لأنفسهم، من دون قوانين، إنشاء صندوق بلدي ينفق أمواله من دون علم البلديات ولا موافقتها، فضَعُفَ دور البلديات التنموي».
بموجب المادة 24 من القانون رقم 665/97 بات المجلس البلدي، يتألّف من أعضاء يُحدّد عددهم كما يلي:
أ- 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصٍ.
ب- 12 عضوًا للبلدية التي يراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخصٍ.
ج- 15 عضوًا للبلدية التي يراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصٍ.
د- 18 عضوًا للبلدية التي يراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخصٍ.
هـ- 21 عضوًا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصٍ.
و- 24 عضوًا لبلديتي بيروت وطرابلس.
يبلغ عدد البلدات والمدن في لبنان اليوم 1634، لكن لا يوجد بلديات سوى في 1065 منها فقط لأنّ ذلك مرتبط بعدد الأهالي المسجّلين في البلدة، وبإلزامية ورود اسم البلدة والمدينة في الجدول رقم(1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954. وقد تطوّر عدد البلديات في لبنان منذ العام 1864 وحتى العام 2025 على الشكل الذي يبيّنه الجدول رقم 5.
أما الدورات الانتخابية التي أُجريت فكانت على التوالي:
1934 – 1952 – 1963 – 1998 – 2004 – 2010 – 2016 – 2025.
تعاني مختلف البلديات اليوم عجزًا ماليًا، كما أنّ بعضها يعاني الشلل الإداري والانقسام الحاد بين أعضائها، وهو أمرٌ يعطل آليات العمل، كما أنّ التدخلات ببعض البلديات عطّلت عملها. في المقابل، ينشط بكثافة التعاون بين بعض المجالس البلدية والمنظمات الدولية والمانحة، وذلك كتعويضٍ عن عدم وجود قدرة لدى الدولة على تأمين تمويل كافٍ لمشاريع عديدة تحتاج إليها البلدات والمدن. مثلًا، بلغت مؤخّرًا عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع نحو 61 مليار ليرة لبلدية بيروت، في حين نالت بلدية الشقدوف في عكار مبلغ 14 مليون ليرة فقط، وهذه المبالغ تطرح السؤال حول قدرة البلديات على القيام بالمهمات المناطة لها وبالتالي الجدوى من وجود بلديات صغيرة. كما أنّ قانون البلديات يحتاج إلى تعديل وتطوير ليتماشى مع الحداثة، مثلًا لماذا لا ينتخب المكلّف أعضاء البلدية في المنطقة التي يسكنها ويملك فيها عقارًا حيث يدفع الرسوم على القيمة التأجيرية وصيانة المجارير والأرصفة، وهذا ما يحصل في الدول المتقدمة التي تسعى إلى إشراك سكان المدينة في تطويرها؟ ولماذا لا يتم تفعيل أجهزة الرقابة لمنع استغلال الصلاحيات البلدية لمنافع شخصية أو فئوية؟ ولماذا لا يتم اعتماد النسبية كما في الانتخابات النيابية ما يضمن تمثيل كل لائحة مرشّحة إلى المجلس البلدي وفق عدد الأصوات التي تحصل عليها؟ هذا غيض من فيض أسئلة تُطرح في سياق الحديث عن أهمية دور البلديات كسلطات محلية، وضرورة تفعيله خصوصًا في بلد يعاني ما يعانيه من أزمات.
أخيرًا، هل يكون ما شهدناه من اندفاع الشباب للترشح للانتخابات البلدية مدخلًا للسير نحو آفاق جديدة من التطور والحداثة، أم أننا ما زلنا أسرى معايير سادت وحكمت اختيار المجالس البلدية، بدءًا من الوجاهة والنفوذ وانتهاءً بغيرها من المعايير، ما يُبقي الدور الفعلي للبلديات واحدًا من الآمال المعلّقة كما في مسرحية «المحطة»؟