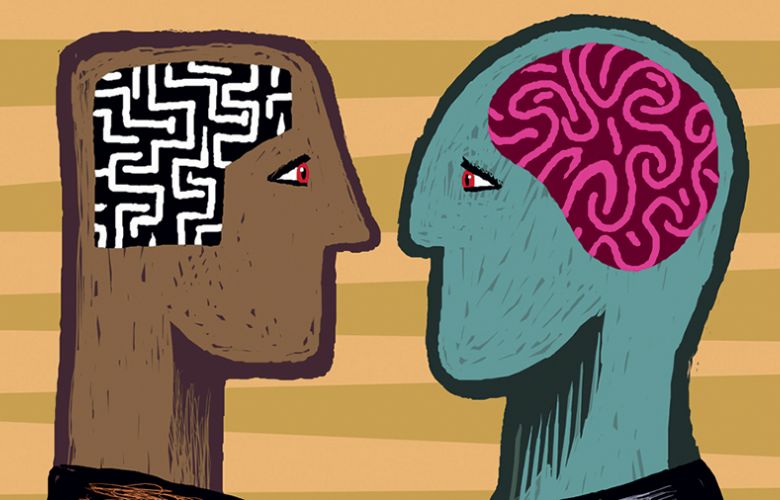- En
- Fr
- عربي
رحلة في الإنسان
المراهقة مرحلة طالما استقطبت اهتمام الباحثين، فالاضطراب والضياع اللذان يسيطران على معظم المراهقين، يطرحان أكثر من فرضيّة حول أسباب وجودهما. فهل يكمن الداء في الأدمغة الطريّة غير المكتملة النمو، أم في معايير الحداثة التي بإمكانها التلاعب بوظائف هذه الأدمغة؟
معطيات مدروسة
حسب رأي الباحث النفساني الأميركي روبيرت إبستاني، والذي أجرى دراسات مخبريّة على أدمغة المراهقين، فإنّ دماغ المراهق لا يختلف عن دماغ البالغ، وخصوصًا لناحية قدرته على استخدام وظائفه. وهنا يشير إبستاني إلى أن جينات الأفراد الوراثيّة، لا تعمل منفردة على صياغة الميول والتوجهات وطرق التفكير، بل تتفاعل مع المؤثرات الخارجية وفي مقدّمها البيئة الاجتماعيّة والعائليّة، وعلى هذا الأساس، تتبرمج وظائف أدمغة المراهقين، الأمر الذي يفرز ميولًا وسلوكيات تطبع كلًا منهم بطابع خاص. وهذا بحسب إبستاني، يضع حدًا لما يشاع عن أنّ انفعالات المراهق غير السويّة، هي في الواقع نتيجة عدم اكتمال وظائف دماغه.
المراهق يمثّل الإنسان البدائي!
إنّ اتّهام المراهق بالتهوّر وانعدام المسؤوليّة بالفطرة، أصبح اليوم مرفوضًا، مع العلم أن نظريات سابقة كانت قد أخذت به، وفي مقدّمها نظريّة العالم النفساني الأميركي ستانلي هيل. ففي العام 1904، نشر هيل كتابه «سن المراهقة»، الذي روّج لنظرية تأخذ بالاعتبار التشابه بين تطوّر الكائن الفرد والتطوّر النشوئي للإنسان. وحسب رأيه، فإنّ مرحلة المراهقة تتضمّــن تمثيــلًا لحـقبـــة الإنسان البدائي. وعلى الرغم من إسقاط هذه النظريّة في العام 1930، إلّا أن البعض ما زال يؤمن بأن اضطراب سن المراهقة هو صفة مميّزة لهذه المرحلة الانتقاليّة من العمر.
الواقع الأليم
الأهم في الموضوع هو أنّ مراهقي اليوم يزدادون اضطرابًا، وخصوصًا في المجتمعات الحديثة. ففي هذه المجتمعات، تكثر جرائم العنف المرتكبة من قبل أفراد لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة. هذا بالإضافة إلى تزايد نسبة الأمراض النفسيّة بين المراهقين، والتورّط في تعاطي المخدّرات، ومحاولات الانتحار التي تكثر في دول الغرب، وخصوصًا، الولايات المتّحدة الأميركيّة. وكان قد عرف من مراجع مسؤولة أن المدارس والجامعات الأميركية في بعض الولايات، أصبحت كالسجون بسبب التخوّف من جرائم العنف داخل حرمها. فمداخلها وأسوارها مزروعة بكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، إضافة إلى إحاطتها برجال الشرطة الذين يجوبون محيطها باستمرار، ويفتّشون الداخلين إليها.
إنّه بالفعل واقع مأسوي يطرح أكثر من سؤال حول هذه الظاهرة الغريبة والمتفشّية. أما الأسئلة الأكثر إلحاحًا فهي: إذا كان الاضطراب السلوكي يعتبر جزءًا من مرحلة المراهقة التطوّريّة، فلماذا يتعاظم هذا الاضطراب في الدول الغربيّة ويتضاءل أو يكون معدومًا في دول أخرى؟
الاعتبارات الحضاريّة ودور الحداثة
في العام 1991 قامت مجموعة من علماء النفس والاجتماع في جامعة أريزونا الأميركيّة، بمراجعة أبحاث تناولت 186 مجتمعًا غير صناعي. وبالنتيجة، تبيّن أن كلمة مراهق لم تدخل في قواميس نحو الستين بالمئة من هذه المجتمعات. أما سبب ذلك، فهو أن المراهقين فيها يمضون معظم أوقاتهم برفقة البالغين، ويضطّرون إلى تحمّل المسؤولية في سنٍ مبكرة. لم تلحظ نتائج الأبحاث المشار إليها ظهور أي من عوارض الاضطرابات السلوكيّة في صفوفهم. وجدير بالذكر في هذا السياق، أنّ الدراسات التي أجريت خلال الثمانينيات في جامعة هارفرد الأميركية – وهو ما أشارت إليه مجلة العلوم الأميركية – لفتت إلى أن مشاكل المراهقين بدأت بالظهور في المجتمعات الغربيّة الصناعيّة مع بداية العصرنة، والسبب أن البحبوحة الاقتصادية التي رافقت تلك الحقبة أفسحت في المجال أمام امتداد مرحلة الطفولة، لتشمل ما يعرف اليوم بأولى سنوات المراهقة.
ماذا حصل لأدمغة المراهقين؟
حسب رأي الباحث إبستاني، والذي عبّر عنه في دراسته الأخيرة، فإن الاضطراب الذي يميّز اليوم شخصيّات معظم المراهقين، وخصوصًا في الدول الصناعية والمجتمعات الواقعة تحت تأثيراتها، هو في الواقع نتيجة ما يسمّى بالامتداد غير الطبيعي لمرحلة الطفولة.
فمنذ بداية القرن الماضي، أصبح الوالدان يبالغان في تدليل الأطفال، وهو ما أدّى إلى اعتبار المراهق المتأهب لمرحلة البلوغ، طفلًا يحتاج إلى الحماية. يضاف إلى ذلك أنّ الأهل يبدأون في مرحلة المراهقة بوضع حدٍ فاصلٍ بينهم وبين المراهقين، ويحيطونهم بالقيود والضغوطات الاجتماعية التي لا حصر لها. وقد بيّنت الدراسة المشار إليها، وجود علاقة واضحة بين نسبة التعامل مع المراهق كطفل، وبين نسبة تعرّضه للاضطرابات النفسية المرضيّة، وخصوصًا في حال وجود الاستعداد الوراثي لذلك. ومن هنا يصبح بالإمكان القول: إنّ دماغ المراهق المعاصر المضطرب هو نتيجة حتميّة لسرعة التطّور الحضاري في المجتمعات الحديثة.
نتائج الاختبارات العلميّة
من ناحية ثانية، يشير إبستاني إلى أنّ معظم الدراسات المعاصرة تنفي وجود دلائل علميّة ثابتة على العلاقة بين الصفات البيولوجية الدماغيّة للمراهقين المضطربين، وبين المشاكل التي يتورّطون فيها، وعلى الرغم من أنّ أنشطة أدمغتهم – التي يتم مراقبتها عبر التصوير الرنيني المغناطيسي – تترافق عمومًا مع سلوكياتهم ومشاعرهم السلبية.
إلاّ أن ذلك لا يعني أنّ هذه الأنشطة هي السبب الرئيس لردّات فعلهم المرافقة لها، وحسب ما ورد في كتاب «وضع اللّوم على الدماغ» لاختصاصي الأعصاب الأميركي إليوت فالانستاني، فإنّنا نرتكب خطأ فادحًا إذا ما حمّلنا الدماغ البشري مسؤوليّة جميع السلوكيات غير السويّة. وهو يرى أن الأنشطة الدماغيّة المرئية عبر الصور الشعاعيّة، قد تكون انعكاسًا مباشرًا للانفعالات الناجمة عن ظروف حياتية معيّنة. أو بمعنى آخر، قد تكون انعكاسات لمواقف مؤثرة في عمل الكيميائيات الدماغية، وبالتالي، في تواصل الخلايا العصبيّة، ونشوء الشخصيّة الفرديّة.
من هذا المنطلق، أصبح بالإمكان القول: إنّ شخصيّة المراهق التي يتبارى القائمون على الدراسات في تحليلها، هي وليدة البيئة الاجتماعيّة المتفاعلة مع الجينات الوراثيّة. وإذا ما أخذنا بالاعتبار صحّة هذا المبدأ، نكون قد اعترفنا بصدق أن اضطرابات مراهقينا، هي نتيجة حتميّة للمتغيّرات الاجتماعيّة والتربوية الحاصلة. لماذا إذن لا نبدأ منذ اليوم بحماية أجيالنا الصاعدة من مؤثرات الحداثة، وامتدادات جذور الطفولة، ونزوّدهم ما يحتاجون إليه لمواجهة الحياة بثقة ومسؤولية؟