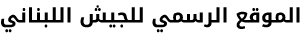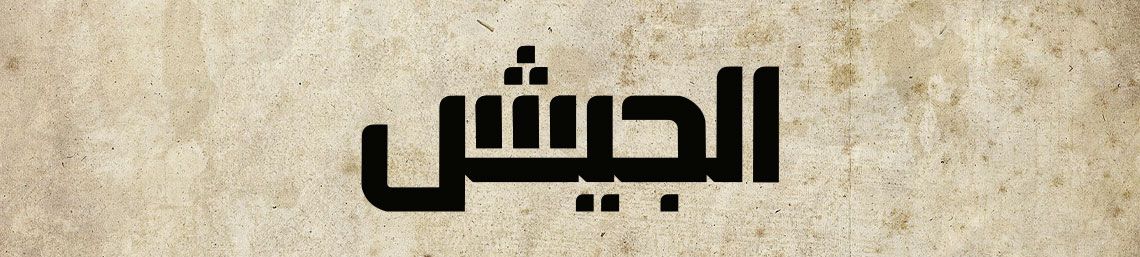- En
- Fr
- عربي
وجهة نظر
تفتيت كيانات ... وتفكيك تحالفات
يتصدر كتاب ”الشرق الأوسط الجديد“ واجهات الاهتمام. يشغل مراكز الأبحاث والدراسات. يثير اهتمام عواصم دول القرار. يحتل عناوين الصحف، وأعمدة المقالات. يأخذ شعوب المنطقة نحو مجاهل الأقدار، حيث الحياة والموت يتأرجحان على وقع المفاجآت، وحيث المصير والمستقبل يسبحان في فضاء الغموض.
كتاب محبّر بسرديات مؤلمة، من دون توقيع. ليس من مؤلف واحد، ربما مجموعة من أهل الاختصاص المهرة في وصل شبكات المصالح. مستثمرون مهرة في قطاع الحديد والنار. منظّرون في قراءة الزمن المتغير، بدءًا من التعقيدات، وصولًا إلى المخرّجات. لكنّ أحدًا لم يوقّع بعد.
كتاب من عدّة فصول لم تكتمل. تبدأ المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنقسم إلى بعدَين:
- الأول: حرب الـ12 يومًا، ونتائجها، والتداعيات التي لم تنتهِ فصولًا بعد.
- الثاني: اختبار الأسلحة لدى كل طرف، ومدى فعاليتها. وقد أُتيحت للطرف الأميركي أن يختبر ميدانيًا مدى قدرة قاذفة الشبح العملاقة، وفعالية القنبلة الخارقة للتحصينات، والتي يزيد وزنها عن 13 طنًا.
تنساب سردية الحرب، وتطول. يتصدرها قوس من المجامر المتأججة، يمتد من قطاع غزّة، وصولًا إلى اليمن، مرورًا بشطآن ورواسٍ، ودول وكيانات، وحسابات صعبة، متشابكة، لا تستند إلى قاعدة، وتنعم بوافر من الألقاب والمصطلحات.
متى النهاية لهذا الفصل عن ملحقاته؟
لا جواب بعد، طالما أنّ الأسهم النارية ما زالت تفرقع في سماء المنطقة، فيما القافلة تمضي على متن خيط من السراب، معلّق ما بين الثريا والثرى؟!
ويمتدّ الفصل الثاني من الكتاب من مقلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو ما يُعرف بقاذفات الشبح، والقنابل الخارقة للتحصينات، إلى مواقع تخصيب اليورانيوم. لا الرواية في هذا الفصل انتهت، ولا الحقيقة اهتدت إلى معاقلها وسط هذا الزحام من الكلام عن النصر والانتصار الذي يدّعيه كل طرف. يكفي القول بأنّ المتورطين قد بلغوا المنعطف الصعب:
• الحوار، لا بد منه مهما زادت التعقيدات، وطالت المناكفات كونه يشكّل الملاذ الأخير، وأقصر الطرق للخروج من النفق.
• استئناف المواجهات؟! احتمال مستبعد، لكن دفة بابه لم تُوصد بعد.
• اللجوء إلى دبلوماسية «الخطوة خطوة». إنّها قائمة. عاود الإيراني جلوسه إلى طاولة المفاوضات وجهًا لوجه مع «الترويكا» الأوروبية: فرنسا، بريطانيا، وألمانيا؛ فيما بعض عواصم دول الخليج تنشط لتدوير الزوايا الحادة بين طهران وواشنطن، من دون توافر - لغاية كتابة هذه السطور - أساسات واضحة يُبنى عليها.
ويحاكي الفصل الثالث من الكتاب المحاولات الجديّة الرامية إلى إخراج دول في المنطقة من عنق زجاجة «سايكس – بيكو» نحو كيانات جديدة،وخرائط مرسومة على ورق التفتيت، والتجزئة، والفرز والضم.
أما الفصل الآخر، غير الأخير من الكتاب، فينطلق من تغيير الاستراتيجيات، إلى تغيير التحالفات.
يريده الرئيس ترامب شرقًا أوسطًا على مدى طموحاته التي لا تنتهي، ولا حدود لها على صفحة الواقع. ويريده نتنياهو إربًا إربًا مقسّمة بين دويلات، وفئويات، وعصبيات، وسناجق، وتوابع. في المقابل يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصديقه وحليفه الرئيس الصيني شي جينبينغ درة العقد، في عالم متعدد الأقطاب، بديلًا عن سياسات القطب الواحد.
ارتدادات اقتصادية مكلفة
من الفصول، إلى المتفرعات، يقول أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي: «إنّ الحرب دارت، وتدور في منطقة حساسة بالنسبة إلى التجارة العالمية، وأي خلل يحدث في مسارات التجارة سيترك أثرًا سلبيًا على سلاسل الإمدادات العالمية».
ويرى «أنّ العالم يعاني حالًا من القلق حول إمداد النفط، وتأثيره على الحركة الاقتصادية، نتيجة الحرب بين إسرائيل وإيران». ويعتبر «أنّ الركود العالمي وارد جدًا، وهناك حالة من الضبابية، وعدم التأكد بالنسبة إلى المستثمرين. وإذا تمّ الوصول إلى تسويات في منطقة الشرق الأوسط، ستحدث استثمارات كبيرة». و«إنّ فهم سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات أمرًا صعبًا، ولا أحد يستطيع تفسير التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض».
ووصفت مؤسسات دولية، ومراكز أبحاث اقتصادية، الحرب على إيران بأنّها أكبر تصعيد عسكري إقليمي في السنوات العشر الأخيرة، و«أنّها حرب تكسير عظام حقيقية» يتوقف الصمود فيها على القدرات العسكرية، والقوة الاقتصادية، والدعم الدولي، والمساندة الشعبية. وعلى الرغم من طبيعتها الجغرافية المحدودة، فإنّ آثارها الاقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة بعد الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية لتطال:
• أسعار النفط، وأسواق الطاقة.
• حركة الشحن والتجارة العالمية.
• تدفقات الاستثمارات الخارجية.
• قطاعات السياحة، والنقل، والعقارات.
• سلاسل التوريد العالمية.
• تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، وأسعار العملات المحلية، وأسعار الذهب، واستقرار الاقتصادات العالمية، الإقليمية والمحلية.
وقد لاحظ الخبراء تراجع التجارة البينية بين دول المنطقة، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، وتناقص الاستثمارات، وتأثّر قطاعات السياحة والنقل واللوجستيات، وازدياد تكلفة تذاكر السفر، وتراجع أعمال الفندقة، والضيافة، وتهديد مضيق هرمز، وتحوّلًا في خطوط الملاحة إذ يمر عبر هذا المضيق نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية. ومع تهديدات إيران بإغلاقه بعد الهجمات الأميركية، بدأت شركات الشحن العالمية بتحويل مساراتها، ما زاد المدة التي يستلزمها الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو 7 إلى 10 أيام، ورفع كلفة التأمين البحري بنسبة تجاوزت 300 في المئة.
تأثيرات الحرب على حركة التجارة العالمية
حدث تباطؤ في تدفق السلع، وخصوصًا الطاقة، والمواد الخام الصناعية، إذ أشارت تقارير مركز CEBR البريطاني إلى انخفاض مرتقب في حجم التجارة العالمية بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثالث من 2025 إذا استمر النزاع. وتوقع المركز ارتفاع أسعار النقل واللوجستيات، وهو ما حدّ من القدرة الشرائية العالمية فضلًا عن الضغط على سلاسل الإمداد الغذائي.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10 في المئة خلال الأسبوع الأول للحرب، ما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وتقلّص في الاستثمارات.
كذلك، خسر مؤشر داو جونز نحو 600 نقطة في منتصف حزيران، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين. وشهدت الأصول الآمنة مثل الذهب، وسندات الخزينة، ارتفاعًا ملحوظًا، مع تفاوت كبير في الأسهم ذات المخاطر العالية، فيما أعادت مؤسسات استثمارية خليجية توجيه رؤوس أموالها نحو القطاع الدفاعي، والطاقة، كخطوط تحوّط استراتيجية.
وحصل تراجع في مؤشرات الأسواق ومعدلات النمو والتضخم، إذ خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 2.7 في المئة، في حين حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ أسعار الطاقة المرتفعة، والقلق الجيوسياسي، قد يرفعان التضخم في الاقتصادات المتقدمة، والناشئة على السواء بسبب تصعيد الحرب. يُضاف إلى ذلك توقّع تباطؤ الاستثمارات الكبرى، وتجميد المشاريع الاستثمارية الخارجية، وازدياد اللجوء إلى الملاذات الآمنة.
أظهرت الحرب مدى هشاشة البنية الاقتصادية الإقليمية أمام الاضطرابات والأزمات الجيوسياسية. كما أنّ دخول أميركا على الخط المباشر، وهجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، وسّع نطاق الحرب، وفتح الباب أمام مآلات اقتصادية خطيرة على المنطقة، وربما على العالم. ومعلوم أنّ الدول المحيطة ذات الاقتصادات الهشة قد تعرّضت لتصدّعات كبيرة، وأنّ الاقتصادات المتوسطة في المنطقة بدأت تعاني أيضًا تداعيات الحرب على الاقتصاد في الشرق الأوسط.
مضيق هرمز
نصل إلى مضيق هرمز الذي أُصيب بارتجاجات بسيطة. إنّه من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمرّ عبره حوالى 26 – 30 في المئة من تجارة النفط العالمية، بما يعادل نحو 16.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، والمكثفات، بالإضافة إلى أكثر من 20 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
ويشكّل هذا المضيق الضيّق بين الخليج العربي وخليج عُمان، نقطة عبور حيوية للدول الخليجية المنتجة للنفط، مثل السعودية والإمارات والكويت، إذ تمرّ عبره نحو 90 في المئة من صادراتها النفطية.
بالإضافة إلى النفط، يمرّ عبر مضيق هرمز جزء مهم من التجارة العالمية للسلع الأساسية، والحاويات، ما يجعل استقراره أمرًا حيويًا ليس فقط للمنطقة، بل للاقتصاد العالمي بأسره، خصوصًا للدول الآسيوية التي تعتمد على واردات الطاقة في الخليج.
وقد سعت إيران من خلال تهديدها للممرات المائية إلى تعزيز ورقة الضغط في مواجهة «إسرائيل» والغرب. وحاولت «إسرائيل» في المقابل تقويض القدرات الإيرانية النووية والعسكرية مما رفع من احتمالات تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع تشمل البحر الأحمر وباب المندب.
وحضّت الولايات المتحدة الصين على الضغط على إيران لمنع إغلاق مضيق هرمز الرئيسي لصادرات النفط والغاز، بعد أن استهدفت طائرات أميركية منشآت نووية إيرانية رئيسية.
الصين.. و”الحزام والطريق“
أدى النزاع بين إيران و«إسرائيل» إلى تقويض الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الصين منذ سنوات، سعيًا لترسيخ مكانتها كوسيط في الشرق الأوسط، عندما التزمت الحياد أمام تصاعد الحرب.
وكانت قد سهّلت التقارب الدبلوماسي التاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران في العام 2023، وقدّمت نفسها كجهةٍ أكثر حيادًا من الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
بصفتها المستورد الرئيسي للنفط الإيراني، دعمت الصين في السنوات الأخيرة اقتصاد إيران بعدما خنقته العقوبات. لكن في خضم الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الأخيرة، والقصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية، اكتفت الدبلوماسية الصينية بدعوات لخفض التصعيد، من دون أن تقدم على خطوات عمليّة لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
ويقول كريغ سينغلتون المتخصص في الشؤون الصينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث أميركي: «لم تقدم بكين أي مساعدة ملموسة لطهران، وبقيت في الظل».
ويلفت إلى أنّ الصين «اكتفت بنشر تصريحات بينها إدانات، وبيانات للأمم المتحدة، ودعوات للحوار، لأن إعلان وعود كثيرة، ثم تقديم القليل في النهاية يُظهر محدودية قدرتها على التصرف».
ويقول «لوكالة الصحافة الفرنسية» في النتيجة «إنّ موقف بكين الخجول يُظهر ضعف تأثير الصين الحقيقي على إيران، عند اندلاع أعمال عدائية».
يُذكر أنّ بكين عززت علاقاتها مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في العام 2015. وفي العام 2023 وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ العلاقات الثنائية مع طهران بـ«الاستراتيجية»، وأكد دعمه إيران في حربها ضد التضييق عليها.
ويرى المسؤول الصيني المتقاعد ليو تشيانغ، مدير اللجنة الأكاديمية في مركز شنغهاي للدراسات الاستراتيجية الدولية (ريمباك) أنّ «بقاء إيران مسألة أمن قومي للصين».
وكتب في مقال نشر على موقع «ايسي شيانغ» الأكاديمي، أنّ على الصين اتخاذ «تدابير استباقية» في الصراع لضمان «عدم سحق إيران في الحرب، وخنقها من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل».
ويعتبر محللون أنّ علاقات بكين مع طهران تهدف أيضًا إلى موازنة النفوذ الإقليمي للولايات المتحدة و«إسرائيل» ودول الخليج.
ويوضح توفيا غيرينغ الخبير في الشؤون الصينية في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أميركي أيضًا، «أنّ إيران جزء من استراتيجية الصين لمواجهة الهيمنة الأميركية، وبدرجةٍ أقل توسّع حلف شمال الأطلسي».
ويؤكد غيرينغ أنّ «بكين سعت إلى منع انهيار دور إيران الإقليمي كليًا»، مسلطًا الضوء على المبادرات الصينية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
وفي حين أدانت الصين الضربات الأميركية على إيران، ودعت كل الأطراف إلى التهدئة، خصوصًا «إسرائيل». كما أيّدت التوصل إلى تسوية سياسية، ووقف لإطلاق النار، يستبعد محللون أن تزوّد بكين طهران بمعداتٍ عسكرية متطورة، خشية وقوع صدام مباشر مع واشنطن.
ويقول الأستاذ في جامعة إكسيتر (بريطانيا) إندريا غيزيلي إنّ «إيران بحاجةٍ إلى أكثر من مجرد تصريحات في الأمم المتحدة، أو مكونات صواريخ. إنّها بحاجةٍ إلى دفاعات جوية، وطائرات مقاتلة يمكن للصين توفيرها، لكن ذلك سيستغرق وقتًا، ناهيك عن ردّ فعل إسرائيل السلبي جدًا إزاء هذا الموضوع».
من جهته، شكك الباحث في مركز «تشاتام هاوس» البريطاني للأبحاث أحمد ابو دوح في قدرة بكين في التأثير على إيران. وهو يرى «أنّ مكانة الصين في الشرق الأوسط تراجعت بشكلٍ كبير منذ بداية الصراع». ويضيف: «يدرك الجميع في المنطقة أنّ نفوذ الصين للاضطلاع بدورٍ حقيقي في خفض التصعيد محدود، أو ربما معدوم».
الحسابات الصينية
يبدو أنّ الصين هي المتضرر الأول من الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران. فإيران تُعدّ عمقًا استراتيجيًا للصين في قلب آسيا، وصولًا إلى الخليج العربي وبحر العرب.
وقد خسرت الصين كثيرًا من الاستثمارات والعائدات المتوقعة من مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ في العام 2013، لا سيما ما يتعلق بالطريق الذي يبدأ من الصين شرقًا، ويمرّ بباكستان وأفغانستان، ويصل حتى إيران غربًا، ثم يتجه بعد ذلك جنوبًا إلى المحيط الهندي. وإضعاف النظام الإيراني، أو سقوطه، سوف يحوّل الجغرافيا الإيرانية التي تصل مساحتها إلى أكثر من 1.7 مليون كيلومتر مربع إلى مساحة للفوضى، وعدم الاستقرار ما يهدد بوقف الطرق، وخطوط السكك الحديدية التي تسلكها التجارة الصينية من الشرق إلى الغرب. وسوف يشكل ذلك ضربة موجعة «لمبادرة الحزام والطريق» في مسارها الأهم، وهو المسار الآسيوي بعد وصول أول قطار حاويات صيني إلى العاصمة طهران في الأسبوع الأول من شهر حزيران الماضي، أي قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران بأيامٍ قليلة.
وهناك تقديرات أميركية تقول إنّ حدوث فوضى في الجغرافيا الإيرانية يُكلّف الصين 40 في المئة من الاستثمارات التي أنفقتها على «الحزام والطريق» في الجناح الآسيوي.
معضلة ”مضيق ملقا“
إنّ وقوع فوضى في إيران، واستبدال نظامها السياسي سوف ينهي الخطة الصينية بتمرير تجارتها من صادرات وواردات بعيدًا عن «مضيق ملقا».
وتقوم استراتيجية الولايات المتحدة على إغلاق المضيق في حال نشوب حرب بين الصين وتايوان، وهذا يعني أنّ الصين سوف تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة إذا حاولت غزو تايوان التي يطلق عليها في الصين «المسار البديل»، حيث تعتمد الاستراتيجية الأميركية على إغلاق «مضيق ملقا» الذي تمر من خلاله نحو 25 في المئة من التجارة البحرية العالمية - نحو 94 ألف سفينة سنويًا - منها ما يحمل كميات كبيرة من النفط شديد الأهمية للصناعة الصينية، إذ يمر في هذا المضيق ما يقارب ثلثي التجارة الصينية و80 في المئة من وارداتها النفطية.
الجماعات الإرهابية
تفكيك إيران – كما يسعى إليه البعض – أو إضعافها، سيكون خطيرًا على مصالح الصين في باكستان وأفغانستان، ويطلق يد الجماعات الإرهابية بالقرب من حدود هاتين الدولتين بما يعزز نشاط هذه الجماعات على حدود الصين. فـ«داعش» في أفغانستان تتمركز على نحو رئيسي قرب الحدود الصينية، ومن شأن حدوث فوضى في إيران أن يعزز مساحة الفوضى المتاحة أمام تلك الجماعات الإرهابية، وهذا ما ينسف الخطة الصينية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار والسلام في قلب القارة الآسيوية.
خسارة حليف موثوق
تسعى «إسرائيل» إلى تغيير النظام في إيران، إذا قدر لها ذلك، وتقنع الولايات المتحدة بأنّ «أي مساس بالنظام الإيراني سوف يشكل ضربة موجعة للصين، لأنّ إيران ظلت طوال العقود الثلاثة الماضية حليفًا موثوقًا به جدًا للصين، بخاصة بعد توقيع طهران وبكين في 27 أذار 2021 اتفاقية تعاون استراتيجي شامل لمدة 25 عامًا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، والاستثمارات المتبادلة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية، وتُقدّر قيمتها بنحو 400 مليار دولار».
طريق مفتوح إلى الأراضي الصينية
أكدت «إسرائيل» والولايات المتحدة، أنّ طائراتهما باتت تتمتع بحرية الحركة في الأجواء الإيرانية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهذا يشكّل خطورة كبيرة على الأراضي الصينية لأنّه يعني أنّ الطائرات الأميركية يمكن أن تقلع من الشرق الأوسط، وتصل إلى الأراضي الصينية من دون أي اعتراض من الدفاعات الجوية. ويمكن للطائرات الأميركية أن تتحرك بحريةٍ في سوريا والعراق وإيران وأفغانستان، لتصل إلى الأراضي الصينية من دون أي عائق.
نفط ضفتي الخليج
تُعتبر الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تستورد نحو 10 ملايين برميل يوميًا يأتي 90 في المئة منها من منطقة الخليج. ومن شأن عودة النفوذ الأميركي على إيران، بأي صورة من الصور سواء عن طريق إضعاف النظام، أو إسقاطه، أن يُشكّل تهديدًا لاستدامة توريد النفط الإيراني إلى الصين.
ومع استعداد الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات جديدة على النفط الروسي، يمكن أن يشكل هذا الأمر ورقة قوية في يد واشنطن في صراعها الاستراتيجي مع الصين.
المشروع التفتيتي في الشرق الأوسط
إنّ مَن ينكبّون على صياغة «كتاب الشرق الأوسط الجديد» يؤكدون على «جوامع مشتركة» أربعة قد تشكّل الفصل الأكثر إثارة وخطورة، لجهة تفتيت كيانات بارزة، وإيران ضمنًا.
وقد ركّزت صحف أميركية في مقالات حول «الشرق الأوسط الجديد» على الآتي:
أولًا: لا يمكن لإدارة ترامب أن تتخلى عن دعم «إسرائيل» مهما بلغ حجم التباينات في وجهات النظر حول عدة مسائل في الشرق الأوسط مثل غزّة ، وسوريا.
ثانيًا: رفض الرئيس ترامب النيل من رأس النظام الإيراني خلال حرب الـ12 يومًا، لكنّه الآن قد أصبح أكثر ميلًا إلى التغيير، إذا ما أصرت طهران على رفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وفق الشروط الأميركية.
ثالثًا: يتداول بعض الإعلام الأميركي بحججٍ وبراهين قدّمها نتنياهو في محادثاته الأخيرة في واشنطن بأنّ النظام الإيراني لن يحيد عن تخصيب اليورانيوم، ولا عن امتلاك صواريخ باليستية متطورة بعيدة المدى. حتى ولو جلست طهران إلى طاولة المفاوضات وتوصلت مع واشنطن إلى صفقة، فإنّ هذا لا يعني تراجعها عن امتلاك قنبلة نووية، وصواريخ فرط صوتية. وتغيير السلوك، لا يكون إلّا بتغيير النظام؟!
رابعًا: وفق قراءة إسرائيلية ـ أميركية، إنّ إيران رغم ما أصابها من وهن، عادت من جديد لتمد محور الممانعة بمنشطاتٍ من مناطق متعددة، وبالتالي إذا كان لا بد من الاستقرار، فيجب الذهاب باتجاه التغيير؟!
تفكيك التحالف الروسي - الإيراني - الصيني
لعل الفصل الأكثر إثارة في الكتاب هو المتعلق بالمحاولة الأميركية الإسرائيلية لفك عرى التحالف القائم بين روسيا وإيران والصين، وإنّ السعي لإضعاف إيران إنما هو سعي لفك حجر العقد في القنطرة، فعندما يُنزع من مكانه، تنهار قنطرة التحالف الثلاثي.
استهداف الصين، سعي يومي، وورشة قائمة، واستهداف روسيا لا يرقى إليه شك.
لقد شكّلت إيران مع روسيا، والصين وكوريا الشمالية «الرباعي» الرافض للهيمنة الأميركية على العالم. ويتصدر هذا «الرباعي» مجموعة الدول التي ترفض النظام القائم منذ العام 1945 بقيادة الولايات المتحدة، وفرض العقوبات خارج مجلس الأمن الدولي.
كما أنّ إيران كانت حليفًا ثابتًا في دعمها لروسيا بعد محاولة الغرب عزل موسكو وهزيمتها استراتيجيًا خلال سنوات الحرب على أوكرانيا. ومن شأن إضعاف إيران، أو إسقاط نظامها، أو تفتيت جغرافيتها، أن يشكّل خسارة لروسيا، بخاصة بعد توقيع المعاهدة الإيرانية – الروسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في 17 كانون الثاني الماضي، وهي معاهدة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي، وتخفيف تأثير العقوبات الأميركية، وتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.
القوقاز وآسيا الوسطى
إنّ إضعاف إيران يعني عمليًا إضعاف حليف قوي لروسيا في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، حيث تؤدي أي معادلة فيها ضعف طهران إلى خسارة أرمينيا حليفة إيران، والتي فيها قطاع شعبي عريض يؤيد دعم العلاقة مع روسيا.
وضعف إيران يعني مكاسب كبيرة لأذربيجان التي توترت علاقاتها مع روسيا خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه دعمت باكو علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وإضعاف إيران، أو انسحابها من الدور الذي تؤديه في آسيا الوسطى، سوف يفتح مساحة واسعة أمام حضور أميركي – أوروبي غير مسبوق في آسيا الوسطى. كما أنّه يشكّل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي الروسي، مصدره الترابط بين الجماعات الإرهابية في جنوب القوقاز والتنظيمات المتشددة في الجمهوريات الروسية شمال القوقاز.
مواجهة سياسة القطب الواحد.. والبدائل
تحسس الثلاثي الروسي – الإيراني – الصيني عمق الأهداف التي يبغي الأميركي تحقيقها من وراء استهداف إيران، فعمد إلى اجتراح بدائل يعزز من خلالها حضوره على المستوى الدولي، ويسعى إلى «عالم متعدد الأقطاب» كبديلٍ عن سياسة «القطب الواحد».
منتدى بطرسبورغ
من هذه البدائل، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وهو حدث تجاري روسي سنوي يُعقد في سانت بطرسبورغ منذ العام 1997، وتحت رعاية رئيس روسيا منذ العام 2006. انعقد منتدى بطرسبورغ هذا العام في حزيران الماضي، وسط ظروف اقتصادية وسياسية عالمية متشابكة، حيث يسود العالم في هذه المرحلة تباطؤ نسبي في النمو، مع تحديات متمثلة في ارتفاع معدلات التضخم، وتنامي النزاعات الإقليمية، واستمرار الضغوط البيئية والتكنولوجية على الحكومات والأسواق.
وجمع المنتدى هذا العام نحو 20 ألف مشارك من 140 دولة، بينهم رؤساء دول، ومسؤولون كبار، ومستثمرون دوليون، وتمحور النقاش حول التجارة متعددة الأطراف، والأمن الغذائي، وتطوير البنى التحتية في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى استراتيجيات القطاع الصناعي والطاقة.
رابطة دول جنوب شرق آسيا
ومن التكتلات التي يعوّل عليها الثلاثي الروسي – الإيراني – الصيني، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهي اجتماع نصف سنوي تعقده الدول الأعضاء لمناقشة التنمية الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
وفي ظل الحرب الاقتصادية المفتوحة ما بين واشنطن وبكين، توجّه الزعيم الصيني شي جينبينغ في الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 18 نيسان الماضي إلى دول ثلاث أعضاء في الرابطة، هي فيتنام وماليزيا وكمبوديا، وكان اتفاق على تعددية النظام التجاري الدولي، وانفتاحه، وأهمية القواعد التي أُرسيت في ظل منظمة التجارة العالمية، وضرورة عدم وضع عراقيل أمام العولمة الاقتصادية نظرًا للمضار الكبيرة التي تعود على الجميع من جراء ذلك.
وتحدث الرئيس الصيني في الدول الثلاث عن ترحيب الصين بمنتجات تلك الدول، في رسالة واضحة إلى ما يمكن أن تقوم به بلاده من تعويض لما قد تفتقده من جراء تراجع صادراتها إلى السوق الأميركية.
بريكس
تشكّل مجموعة دول «بريكس» تحديًا واعدًا ضد سياسة «القطب الواحد». وتضم المجموعة عشر دول هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى: مصر، وإيران، والإمارات، وإثيوبيا، وأندونيسيا، وتشارك السعودية بصفة مراقب.
عقدت مجموعة «بريكس» قمتها هذا العام في ريو دي جانيرو – البرازيل في الفترة من 6 إلى 7 تموز، وناقشت جدول أعمال حافلًا.
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الكاثوليكية بساو باولو ريرتي ابولينارو إنّ الكتلة توسعت من 5 إلى 11 عضوًا، بمشاركة دول عدة كشركاء وأعضاء، وهو ما يعكس تنامي الطموحات لدى دول الجنوب العالمي.
اقتصاديًا، يرى أنّ مجموعة بريكس تسرّع جهودها لتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي. ورغم أنّ إصدار «عملة بريكس الموحدة» ليس أمرًا وشيكًا، فإنّ هناك زخمًا قويًا نحو زيادة استخدام العملات الوطنية، وتطوير بنية تحتية للمدفوعات الرقمية تتمحور حول بريكس بهدف إنهاء «الدولرة».
وكانت قمة البرازيل قد ناقشت موضوعات مفصلية، بينها:
- التخلي عن «الدولرة» عبر التجارة بالعملات المحلية، وأنظمة الدفع الرقمية كخدمة «بريكس باي – BRICS PAY».
- إصلاح الحوكمة العالمية بخاصة في الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي.
- التعاون في مجال المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ30 في البرازيل.
- تنظيم الذكاء الاصطناعي، وشراكات الصحة العامة.
- مكافحة الإرهاب.
في حمأة المنافسة بين أنصار «القطب الواحد»، والساعين إلى «عالم متعدد الأقطاب»، ينشغل العالم بمواصفات الشرق الأوسط الجديد بعد الحرب الأخيرة، وبعد تنامي النزعة نحو «سايكس – بيكو» تفتيتي لكيانات «سايكس – بيكو» الأصلي، وتمكين «الأجواء المفتوحة» من ترسيم حدود دويلات مفتوحة على الفوضى؟!...
هل يُـنجَـز هذا الكتاب، بالتعاون مع متخصصين في «تفتيت الشرق الأوسط»، أم أنّه كتاب غير قابل للنشر؟!